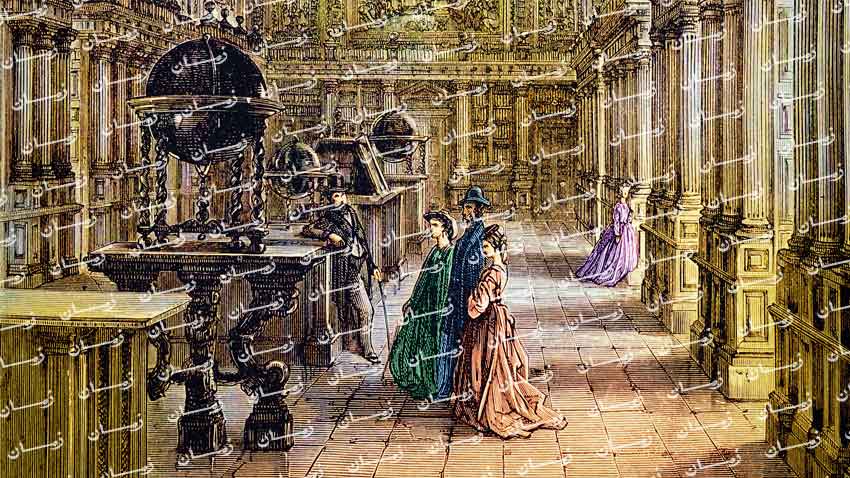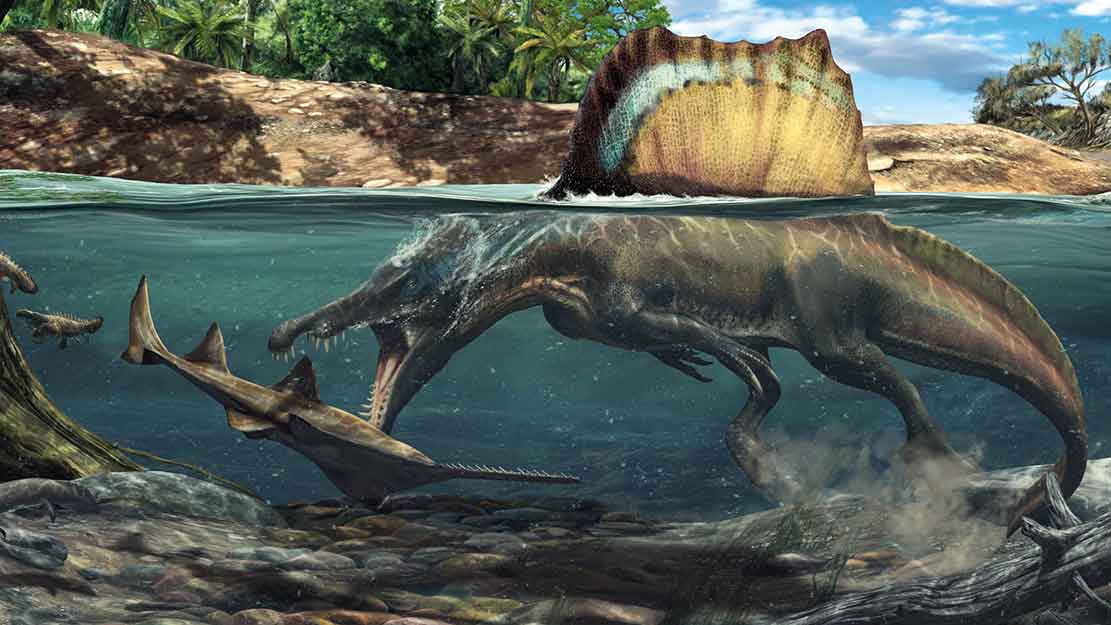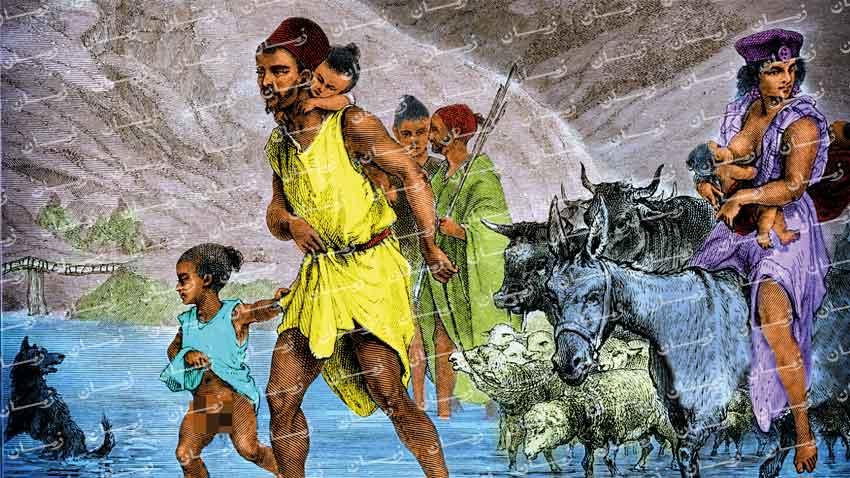تقلب أحمد حرزني بين عدة مناصب سياسية وأكاديمية واستشارية قبل أن يغدو سفيرا متجولا مكلفا بحقوق الإنسان. وخلال سنوات الرصاص، ذاق مرارة الاعتقال والتعذيب، إذ كان من طليعة الجيل الأول الذي وطأ السجن سنة ،1972 ممن كانوا يحلمون بالتغيير الثوري المضاد لعنف الدولة آنذاك، قبل أن يغير آراءه ومواقفه. وقد أكمل دراسته الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية لينال منها درجة الدكتوراه في السوسيولوجيا. وخلال العهد الجديد، قدم حرزني شهادته ضمن جلسات هيأة ”الإنصاف والمصالحة” حول ما عاشه، ثم أضحى بعد سنوات قليلة على رأس “المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان” خلفا للراحل إدريس بنزكري. في هذا الحوار مع مجلة ”زمان” نتعرف مع حرزني عن تلك التجربة، وعن مساره السياسي المبكر، وكذلك الأدوار التي قام بها للمصالحة بين الإسلاميين وبين القصر، بالإضافة للتفصيل في خبايا التعثر خلال تأسيس ”اليسار الاشتراكي الموحد .”كما يطلعنا عن بعض القضايا التي اشتغل عليها المجلس الاستشاري وما تزال معلقة.
قبل أن ننتقل معك إلى مسارك الشخصي والتعليمي، نريد في البداية أن نسألك عن أدوار”سفير متجول مكلف بحقوق الإنسان”، لأن البعض قد يقول إن المغرب مؤخرا أضحى حابلا بالقضايا الحقوقية، في مقدمتها اعتقال الصحافيين والناشطين، وكذلك ما عبر عنه البرلمان الأوربي بخصوص المغرب وقضايا أخرى.. بمعنى آخر قد يقال : أين اختفى الأستاذ حرزني عن الساحة الحقوقية في خضم هذه الأحداث المحلية والوطنية؟
منذ تعييني من طرف صاحب الجلالة كسفير متجول، كان فهمي لدوري أنه يتمثل في إنجاز المهمات التي قد يكلفني بها جلالته، وأيضا المشاركة في بعض الأنشطة الدبلوماسية بطلب من الوزير، ومساعدة سفراء مقيمين في بلدان أجنبية على تنفيذ جوانب محددة من مهامهم، كالتعامل مع الإعلام أو الإسهام في أنشطة جامعية، وذلك أيضا بطلب منهم وبإذن من الوزير .وهكذا، قمت بعدد من المهام قبل أن يجمد “كوفيد“ الحركة كلها أو يكاد. الأمر لا يتعلق إذن بـ“اختفاء“ وإنما يتعلق باحترام صارم لحدود التكليف، وبحرص على عدم إلقاء أية مساحة ظل على الفاعلين الآخرين في الميدان نفسه، وبتغير الظروف الدولية.
بالانتقال إلى بداياتك الأولى، ماذا تتذكر عن طفولتك والمدرسة الأولى التي تعلمت بها؟
جل ذكريات الطفولة الأولى التي أحتفظ بها مرتبطة بتواجدنا كعائلة في مدينة صفرو، وسمتها العامة: السعادة. بيت محب، جيران محبون كذلك ومحبوبون، وبيئة محيطة خلابة بخضرتها وشلالاتها، وبجبل “بويبلان“ المطل على المدينة. طبعا لم تخل تلك الفترة من لحظات إحباط وتحسر وشعور بالغربة، ولكن طابعها الغالب كان كما أسلفت هو السعادة. الشعور نفسه بقي صامدا لما التحقت بالمدرسة، حيث احتضنتني على الخصوص معلمة فرنسية من أطيب الناس .للأسف لم يطل تتلمذي عليها، لأن العائلة رحلت إلى الدار البيضاء خلال خريف سنة ،1955 وأذكر أنها بهذه المناسبة الحزينة أهدتني طقم أدوات مدرسية كاملا. البيضاء في ذاكرتي ووجداني هي عكس صفرو تماما، شراسة في كل مكان، حتى في المظاهرات التي رافقت إلى بعضها أمي، والتي كانت تقام تدعيما لاستقلال المغرب الذي أعلن مبدئيا إثر محادثات “لاسيل سان كلو“ سنة ،1955 إذ بدون حماية يمكن أن يداس المرء، خاصة إذا كان طفلا، بلا اكتراث من طرف الجموع.
إلا أن شراسة العيش في البيضاء كانت تُلمس على الخصوص في الشارع وفي وسائل النقل، خلال فترة كان ينقلني – مردفا على دراجته الهوائية – معلم يدرّس القرآن في المدرسة التي كنت مسجلا فيها. كان أصله من قرية مجاورة لدوّار والدي، لهذا لم يكن بوسعه أن يرفض تأدية تلك الخدمة. وكم مرة اصطدمنا بدراجة أخرى، أو عربة خضر، وسقطنا على الرصيف.. لا أذكر ! اصطدامات من النوع نفسه حصلت أيضا مع الوالد وهو يقود دراجته النارية..
حاوره غسان الكشوري
تتمة الحوار تجدونها في العدد 113 من مجلتكم «زمان»