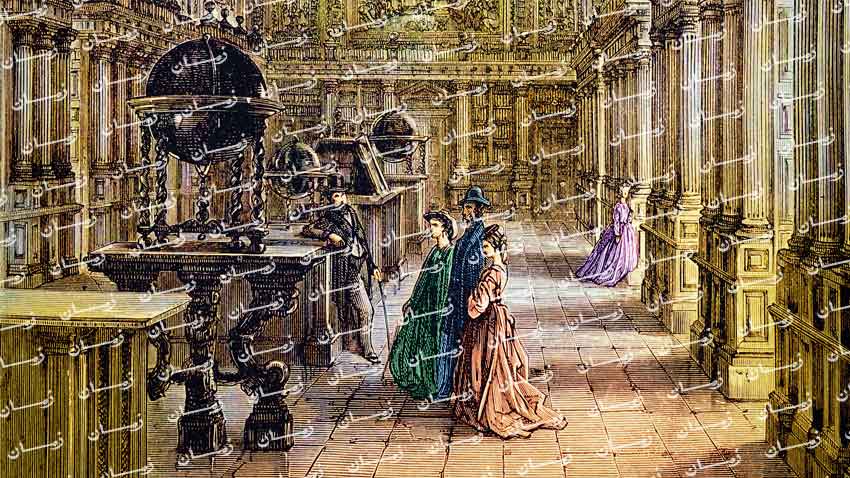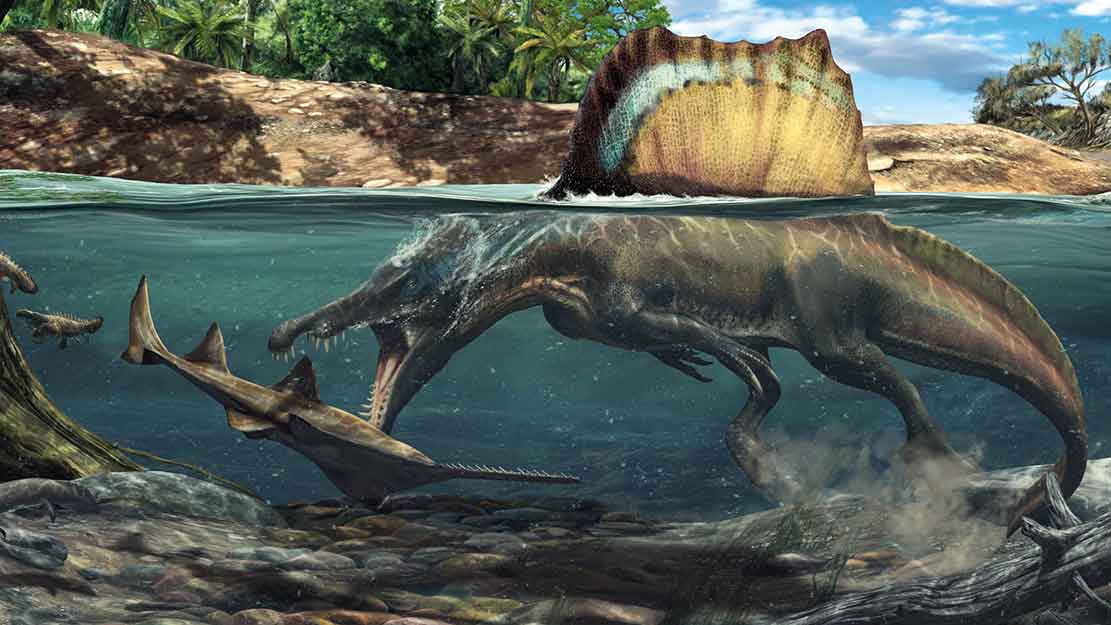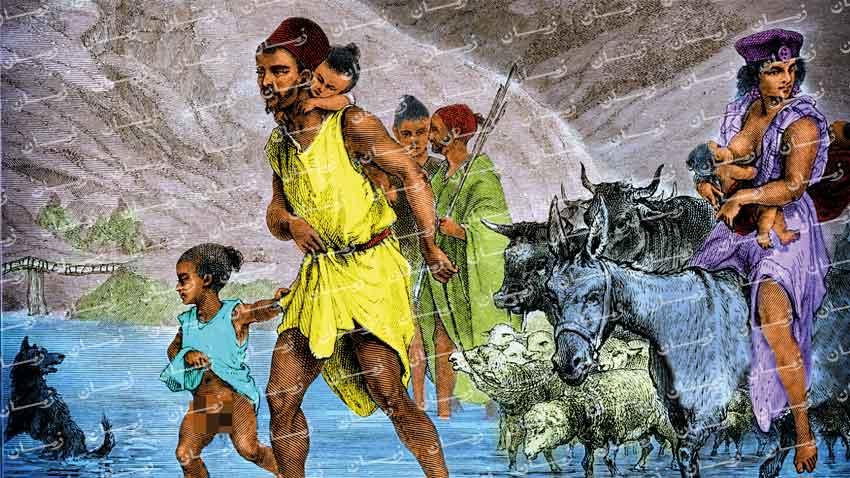لماذا ما تزال قضية الصحراء المغربية تراوح مكانها في أروقة الأمم المتحدة على مدى جيلين؟ كيف استطاع المستعمرون الحفاظ على موطئ قدم في مستعمراتهم السابقة؟ (ما يزال ثغرا سبتة ومليلية المحتلان شاهدين على ذلك). سؤالان يسكنان المخيال المشترك للمواطنين. منذ “مؤتمر مدريد“ ولقاءات أخرى حول الصحراء المغربية، هناك دولتان غائبتان: إسبانيا وفرنسا. يبدو أن غيابهما جزء لا يتجزأ من استراتيجيتهما الجيو–سياسية فيما يتعلق بالمنطقة وبقية العالم. وهو أمر غريب بالنسبة لقوتين استعماريتين، مولعتين بالمناطق الأكثر احتمالا للاحتلال، في الجهات الأربع من البسيطة.
طيلة ما يقرب من نصف قرن من الحديث المتكرر، الذي لا نهاية له، شهدنا بناء إمبراطوريتين استعماريتين في استمراريتهما التاريخية وانتشارهما الجغرافي. كل شيء يحدث كما لو أن مستعمرة ما، يمكنها إخفاء أخرى.
كانت البدايات الأولى من المؤتمر الأول في مدريد في فاتح يوليوز .1880 وقد دل حضور الدول، التي شاركت فيه (الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وهولندا ودول الشمال إلى جانب فرنسا وإسبانيا)، على اهتمام هذه القوى بـالصحراء المغربية، كما كشف عن أطماع القوى الأوربية في المغرب طوال القرنين التاسع عشر والعشرين…
منذئذ، مرت الكثير من المياه تحت الجسر، ومع النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، عمد المغرب إلى تدويل قضية استعادة صحرائه. من الواضح أنها قضية تتعلق بوحدة أراضيه، التي توجد تحت تهديد كبير بالتشتيت والتقطيع. في غضون ذلك، شاركت فرنسا وإسبانيا عن سابق علم، فيما استمرت المناورات على قدم وساق. هكذا، اندفع بعض مواطنينا الصحراويين إلى الاعتقاد بأنه يكفي الانحناء لاكتشاف الذهب الأسود. كانت كذبة جماعية، بل خداع دولة عمد نظام جيراننا الجزائريين إلى الترويج له عن طيب خاطر. بينما أصبح عدد، هنا وهناك، يعانون من فقدان الذاكرة بحالات الصعود والهبوط في قضية ما تزال مستمرة. بدا الأمر، في الأول، كأننا في “سوق للحمقى“، الذي نجح المغرب في تفكيكه بتنظيم “المسيرة الخضراء“ الضخمة، التي شارك فيها 350 ألف مغربي، بهدف إنهاء الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية، قبل أن ينعقد مؤتمر مدريد، يوم 14 نونبر ،1975 وانتهى بإبرام الاتفاقات بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا. ثم تبع ذلك طقوس حقيقية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حول الوضع الحالي ومستقبل الصحراء المغربية، وقد كانت إسبانيا وفرنسا مشاركتين في “اللعبة“ باستمرار، بينما كانت حركات التحرر من الأغلال الاستعمارية تستمر على قدم وساق. سيصاحب هذه الفترة المضطربة في حدودها مع الجيران عامل فرض نفسه أكثر من غيره. يتعلق الأمر، بالضبط، بترسيم الحدود قصد عيش حياة سياسية عادية في المجالين الوطني والإقليمي. لقد وجد المغرب، بحكم طبيعته وثقافته، نفسه في قلب التحول الاستعماري الفرنسي–الإسباني. كما يعلم الجميع، فإن خط الحدود يميل أكثر إلى تلبية مطالب المستعمِرين وليس المستعمَرين .عملت هذه القاعدة، بشكل مثالي، خلال ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر.
لا عجب، إذن، أن تكون الجزائر الفرنسية قد استفادت أفضل من المغرب في خطها المستقيم نحو إنهاء الاستعمار، خاصة وأن المغرب قد شهد للتو واحدة من أكبر هزائمه العسكرية، في معركة إيسلي في شمال غرب البلاد. وستستفحل خساراته أكثر مع معاهدة للامغنية، في 18 مارس .1844ورغم أن المشرعين حاولوا في المادة ،1 من المعاهدة، تجنب أي خلاف على الحدود، أو على الأقل لم يتم المساس بها في الوقت الحالي، إلا أن ذلك لم يمنع أن تكون معاهدة للامغنية مرجعا، بالفعل، لاقتطاعات أخرى. كدليل على ذلك، تم دمج منطقتي تندوف وكولومب بشار، التين كانتا تحت السيادة المغربية آنذاك، في الجزائر الفرنسية، خاصة بعد اكتشاف البترول والمعادن الأخرى، ولا سيما الحديد والمنغنيز. غداة حصوله على استقلاله عام ،1956 سارع المغرب للمطالبة بأراضيه. قبلت فرنسا شريطة الاستغلال المشترك للثروات المعدنية، فضلا عن حظر إيواء المتمردين الجزائريين أو مناقشة إرجاعهم.
في جميع النزاعات الوطنية أو الدولية، يكون الأشخاص الأكثر تورطا هم أول من يتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة. من الواضح أن فرنسا وإسبانيا هما القوتان الاستعماريتان اللتان تسببتا في هذا الصراع. وبهذه الصفة، هما مدعوتان لإيجاد حل خروج سريع ومقبول لدى المستعمرات السابقة، وفي مقدمتها المغرب.
من المؤكد أن أي أرض محتلة تكون فيها كلمة الاستعمار أعلى من كلمة الخاضع له. وبشكل أكثر وضوحا، كانت لفرنسا وإسبانيا مصالح اقتصادية ترفض أي ميل سياسي مناهض للاستعمار .على هذا المستوى، وليس في أي جهة أخرى، يمكن تقدير مواقف إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بقيمتها الحقيقية. وعكس ذلك، ستكون باريس ومدريد مرجعين أساسيين يحولان دون رفع الحظر الدبلوماسي عن الصحراء المغربية.
يوسف شميرو
مدير النشر