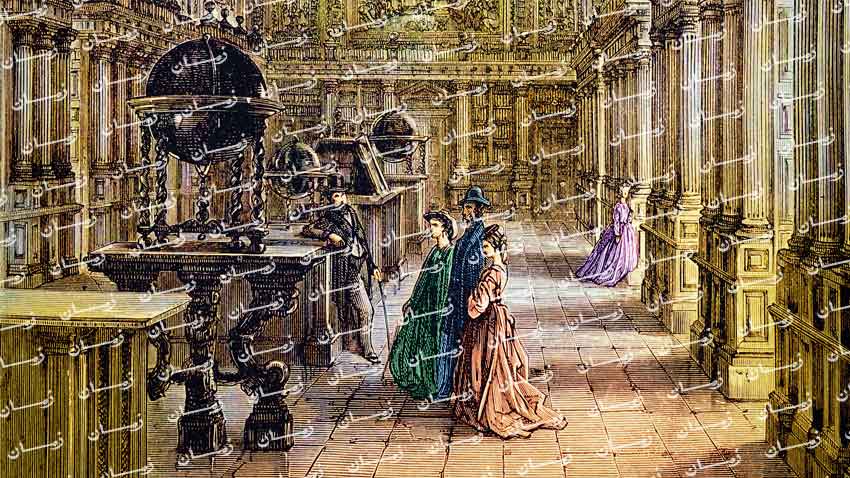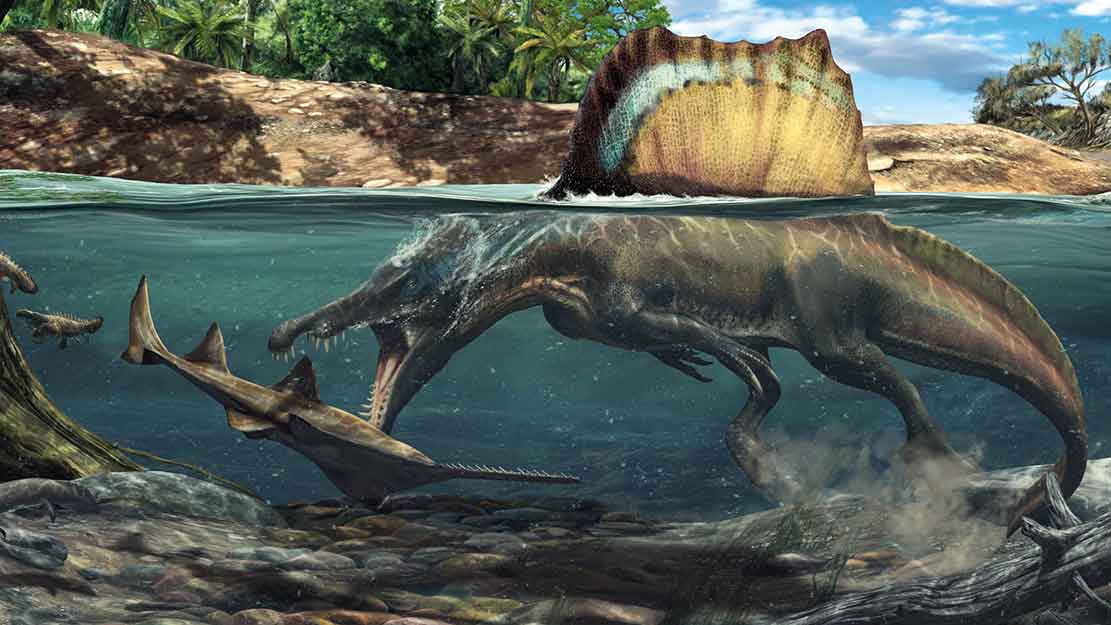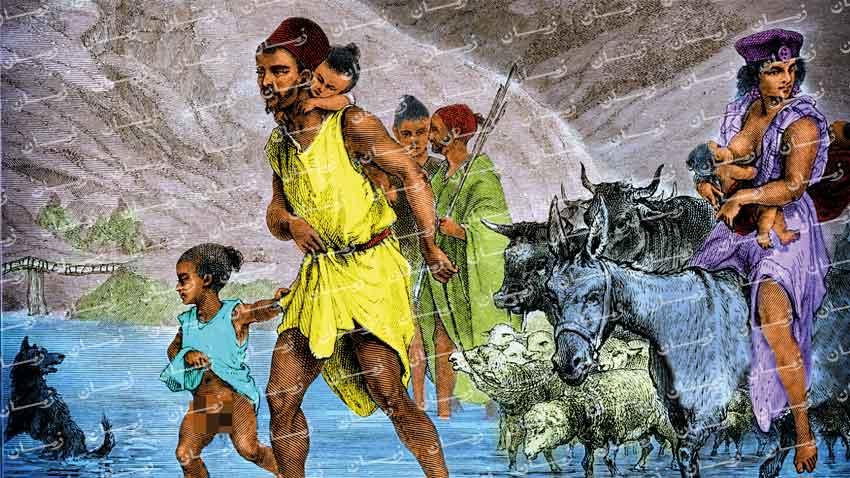تهتز الساحة الإعلامية والثقافية، من حين لآخر، تحت وقع مناقشات تبدو مهمة من حيث المواضيع التي تثيرها. إلا أنها تمر كالعاصفة، ولا تترك وراءها إلا بعض الدمار الذي يطال الأفراد والجماعات، ويستبطن في المخيال الجماعي كإرث سلبي قد يجهض كل محاولة مستقبلية لمعالجة الموضوع من جديد.
آخر مثال يجسد هذه الحالة غير السليمة في سلوكنا الجماعي، هي الضجة المثارة حول “اعتماد الدارجة المغربية” كلغة تدريس. نقول حالة غير سليمة لأننا في كل مرة نتطرق للموضوع المثار كأنه يطرح علينا في حينه، بدون تاريخ ولا تجارب فارطة. كأن المتنافسين لا علم لهم، بما سبق، أو لا رغبة لهم في الإحاطة بذلك. كأننا أمام عدمية تاريخية لا تستوعب مفهوم التراكم ودوره في تطوير المعرفة الإنسانية والدرايات والمهارات الذهنية والعملية. فبالرغم من الكفاءات الفردية المغربية التي تركت بصماتها على التراث الكوني، سواء تعلق الأمر بالابتكار العلمي أو الإبداع الأدبي والفني، فإن النبوغ المغربي لم يرق إلى نبوغ شعب أو أمة. فالهدر ليس فقط على مستوى المدرسة، إنه سلوك عام يطال الدولة ومؤسساتها، والمجتمع وفضاءاته المنظمة.
قد يبدو كلامنا ضربا من التشاؤم، وقطعية لا تخلو بدورها من عدمية، إلا أن ما سيبدد هذا الانطباع الأولي هو تأكيدنا على أن تجاوز هذا الإرث السلبي يندرج ضمن ممكنات المستقبل.
فالمغاربة، وخصوصا أنتلجنسياتهم، قادرون على كسر الحلقة المفرغة التي تجهض إيجابيات لحظات مناقشاتهم الحماسية، التي غالبا ما لا يكون لها غد.
المغاربة قادرون، فهل هم فاعلون؟
هذا هو السلوك المركزي. لنعالجه على ضوء التجربة الأخيرة. فإثر مبادرة لفعاليات جمعوية، صيغت توصيات حول اعتماد الدارجة المغربية كلغة تدريس. وقد حضر هذا النشاط المدني غير الرسمي مستشار للملك محمد السادس وشخصيتان سيتقلدان حقائب وزارية منها وزارة التربية الوطنية. فانفجر النقاش كما ينفجر بركان نائم. واصطف المناقشون، إما وراء المدافعين عن الدارجة كلغة للتواصل الشعبي، وإما وراء المنتصرين للعربية الفصحى كلغة التراث والهوية والقرآن. وجرد كل صف أسلحته، ولم يقتتر في توجيه الطعنات. حتى المفكر المغربي عبدلله العروي، ذو الإشعاع الكوني، لم يبق كعادته، في “مقبعه”، بل اقتحم فضاء العراك، وحاول تجنيد حمولته المعرفية لتطوير المناقشات الحماسية إلى حوار منتج.
وبالرغم من مجهودات هذا المؤرخ-المفكر، سواء على صعيد تبسيط المفاهيم المرتبطة باللغة واللسان والثقافة، أو على صعيد التواصل مع الجمهور الواسع المتتبع لوسائل الإعلام، فإن الذي لا زال يهيمن على لحظة النقاش هذه، ليس الرغبة في الحوار الهادئ والعميق لبلورة مشترك فاعل ومؤسس، بل الهرولة إلى التموقع والاصطفاف، كأن اللحظة لحظة حسم لا تحتمل التأجيل.
أليس المطلوب هو التعميق؟ لماذا ننزلق، كلما طرحت علينا قضية جوهرية كمسألة التنمية، أو المشروع المجتمعي أو التربية والتكوين أو دمقرطة النظام السياسي أو العبور إلى الحداثة.. أو.. أو..، ننزلق إلى الحسم السريع أو التواطؤ الجماعي على تأجيل المسألة إلى أمد لا حد له؟ يبدو أن الدراسة العميقة والجماعية للإشكالات التي يواجهها مجتمعنا أمر ننبذه بالفطرة. نسميه بلغتنا الدارجة “التقلاب على جوا منجل”. فالذي يبحث عن العمق قد يغرق، وحسب التعبير الشعبي “غا يهزو الماء”.
لذلك فالتعقيد، وهو معطى في الطبيعة والحياة، منبوذ في مجتمعنا. فبين الأبيض والأسود لا مكان للون آخر، فإما الحلال وإما الحرام. فحتى لما يتكلم مفكر، كالعروي، ويدعونا لنفض الغبار عن عقلنا المعطل، نتسارع للانتصار له أو الانتصار لغيره؟
المسألة ليست مسألة انتصار، بل مسألة تفاعل جماعي بالإنصات لبعضنا البعض دون شيطنة أو تشنج. المسألة مسألة استدعاء العلم والعلماء وتمكينهم من إنارتنا بكل ما لديهم من صبر وتبصر. المسألة ليست في الحسم السريع لرفع الالتباس، بل في وعي إيجابية الالتباس. فهو لحظة في سيرورة بلورة توجه ما. وعندما يتعلق الأمر بتوجه استراتيجي، فالالتباس تعبير عن تفاوت إدراك الموضوع بين المتحاورين، ورفع الالتباس لا يتم بالاصطفاف ومعارك الحسم، بل بالإنصات الجيد والتفكيك الجماعي للمواقف الجاهزة والتدخل الوازن للعلماء والتنظيم السليم للحوار من لدن المسؤولين.
هذا هو طريق البلورة الجماعية للتوجهات الاستراتيجية. قد يطول مسلسل البلورة ولكنه سيجنبنا الدوران في الحلقات المفرغة التي لم يستفد منها إلا خبراء آخر ساعة. فلكي لا نكرر مآسينا السابقة وبالتالي إخفاقاتنا في قضايا مثل التعريب، إصلاح منظومة التربية والتكوين، بلورة توجهات اقتصادية منتجة، إقرار دستور عصري وحداثي، إرساء أسس مجتمع عادل، منتج، متضامن ومبدع، علينا أن لا نغتال الالتباس. علينا معالجته بهدوء وطول نفس وبآليات منتجة. وفي ما يتعلق بالتجربة الأخيرة حول لغة المنطوق ولغة المكتوب، فالأمل كل الأمل أن تبادر الجهات المسؤولة، الديوان الملكي، الحكومة، المجلس الأعلى للتعليم، إلى تشكيل فريق عمل مكون من علماء وأصحاب الاختصاص وتزويده بكل الوسائل المادية والاجتماعية ليشتغل، بدون تسرع، وليبلور مقترحات تكون قاعدة حوار وطني هادئ وهادف. فالضجة المثارة حول لغة التدريس قد تكون فاتحة خير وخطوة نحو مواطنة مغربية ظلت، لحد الساعة، مشروعا يؤثث الخطابات بينما الممارسات تنتصر للهويات الصغيرة.
المصطفى بوعزيز
المستشار العام