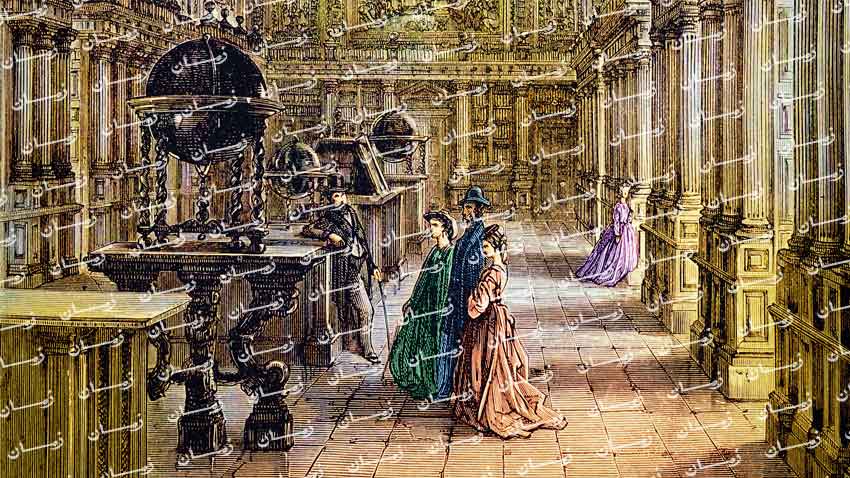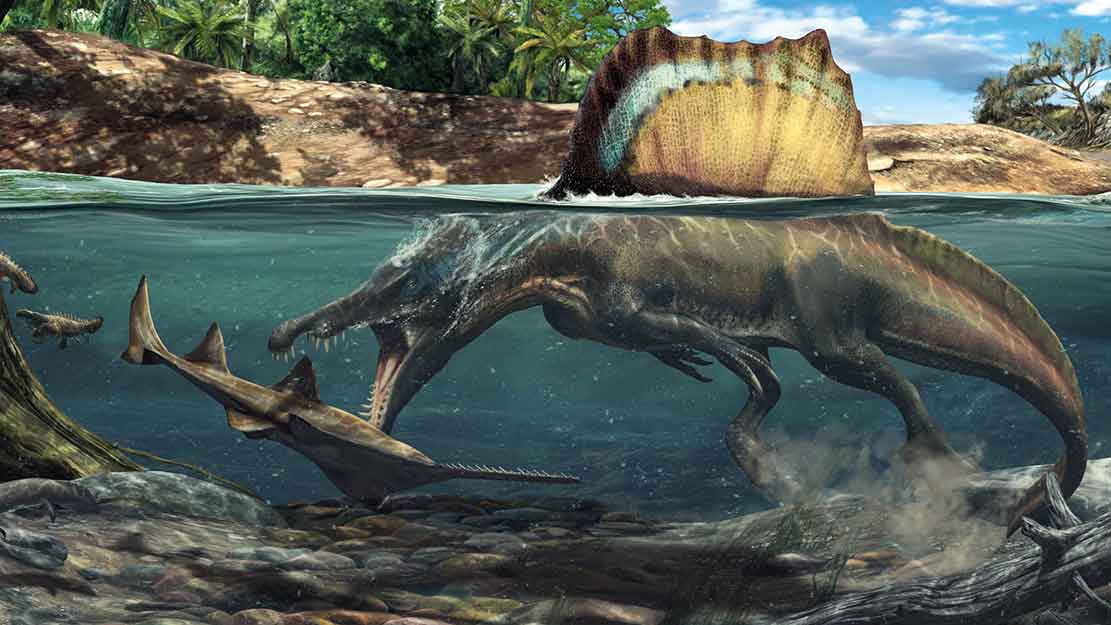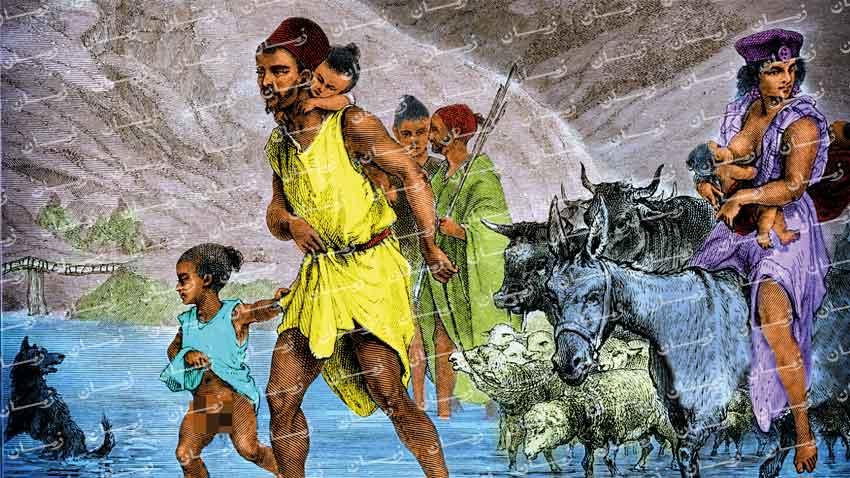تتأثر بلادنا بما يجري في الساحة الدولية ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسيا كذلك، وفي كل أوجه الحياة… فكثير من الظواهر السياسية بالمغرب، ليست نتاجا مغربيا صرفا، ولكنها صدى لما اعتمل في أرجاء أخرى من توجهات، أو استنساخ أساليب معينة، في الممارسة السياسة أو في التدبير، وليس في الأمر عيب حين تكون التوجهات سارية، وطرقها ناجعة، ولكن تُضحي ليس مجرد عيب فقط بل عبئا، حين تكون تلك الاتجاهات أنفقت، أو بعض الأساليب المعهودة أخفقت أو تعثرت.
العالم من حولنا يمور، وهو مُشرع على كل الاحتمالات، وكثير من المرجعيات أنفقت، وأساليب كانت ناجعة، أصبحت متجاوزة، وكما في الملاحة التقليدية حيث لا يمكن للربان أن يؤثر في وجهة الرياح، ولكنه يمكنه أن يوجه الشراع في الاتجاه الذي يبتغي، وفق حركية الرياح، يتوجب على النخب المغربية بمختلف أطيافها، من داخل بنية الدولة، والأحزاب وصانعي الرأي والمثقفين، أن يسعوا جهدهم كي يُوجهوا الرياح العاتية في عالم اليوم، وما قد يلوح غدا، إلى ما يخدم سفينة بلادنا.
لنتركْ جانبا الإيديولوجيا التي يبدو أنها أنفقت، وتَعْدم قوة دفع، مثلما ظهر جليا في انتخابات سبتمبر من السنة الماضية، لنتساءل هل المقاربة التقنية هي الحل؟ هل الأسلوب الحواري، الجامد، الذي يعدم النكهة، هو المَنفذ؟ هل لغة الأرقام والبيانات والاجتماعات، والبيانات المضادة على الاجتماعات، هو جُماع السياسة؟ السياسة ليست بزنس، ولا الدولة مقاولة، ولا الاختلافات مجرد سوء تدبير، يمكن حلها بحسن التدبير أو اختيار زاوية هجوم، أو مجرد الحوار.. الأمور أعقد، ذلك أن السياسة ترتبط بأحاسيس عامة، وبمرجعية، وهي لذلك تحتاج إلى سياسيين يحدثون من وحي هذه الأحاسيس العامة، وباسم مرجعيات، و بخطاب سياسي، فيه حرارة، ينفذ إلى المواطنين، ويؤثر فيهم، وبلسان، وليس بتعتعة، أو تأتأة، تسمى تجاوزا خطابا.
والذي نعرفه في أرجاء عدة من العالم، أن فراغ خطاب سياسي، وغياب سياسيين، أو ضعف خطابهم أو ضحالتهم، أو تنابزهم، أو فقدان أحاسيس عامة في الشأن العام، هو ما يغري بخطابات شعبوية… تبدأ الشعبوية من النداء بمسح الطاولة والتجني على ما هو قائم، من نخب قائمة ومؤسسات، لرد الأمور للشعب، وللشباب، والقوى الحية… في شعارات مغرية. في خضم هذا الجو الذي يكتنفه الضباب، تُعبر الجماهير عن تذمرها من محترفي السياسية وتلقي بنفسها في حضن نكرة، من غير رصيد يَعدها جنة النعيم… والأمثلة عدة.
بيد أن الخطاب الشعبوي إذا كان يخضع لظرفية معية وعناصر موضوعية، فليس بحل…
فهل نأمن إغراء الخطاب الشعبوي في بلادنا أمام ضحالة الخطاب السياسي، وبرودة الطرح التقني، كما “إست“ الحوّات في “الليالي“ كما يقول المثل المغربي، لا يثير الحركة، ولا يرفع الغمة، حتى ولو تدثر بلغة الأرقام وسحر الأوهام… لا يجد الخطاب الشعبوي العَنَت أن يوجه له الضربة القاضية، في أول منعرج، لأنه بارد جامد، لا يسمن ولا يغني من جوع…
طبعا، السياسة ليست شأن الأحزاب فقط، ولا تُختزل في موسم الانتخابات، أو مجرد تمثيل، أو حقائب، أو أدوات السياسة المعهودة. يُفترض أن تكون المؤسسات القائمة الإطار الأمثل لحوار عميق، وطرح أصيل، ورؤى ولو اختلفت، تنِمّ عن عمق، وتوجه فكري أو إيديولوجي، ومقاربات منسجمة في القضايا المصيرية، كما فيما يخص توزيع الثروة، والدفع بالاقتصاد والارتقاء بالمنظومة التربوية. وإلى جانب المؤسسات، تكون الصحافة والساحة العامة عموما، الفضاء الذي يحتضن نقاشا مستمرا وثريا لعرض تصورات بديلة ونقاش رصين .وكل هذا غائب أو يغيب عن الساحة… أي حزب له رؤية متكاملة حول القضايا المحورية، وأي منبر يتضمن نقاشا ثريا، وأي سياسي “يْبرّد“ القلب، في الخطاب والتوجه، والقدرة على الإفحام (بالفاء)، عدا شيء من الدغدغة، وحكي الحكواتية، والظهور الفج، والتحليل السطحي، والبذاءة في التعبير، من دون استثناء.
سبق للمرحوم الحسن الثاني أن حذّر من السكتة القلبية، ومن ظاهرة السيرك. وما يتهددنا أسوأ من السكتة القلبية، وأدنى من السيرك، وهو الألزهايمر، حيث نوجد بأجسامنا (العامة) في الحياة العامة، لا بعقولنا، أو بذكائنا الجماعي، ولكن بمجرد الوجود، في خطابات هلامية، بلا اتساق يختلط فيها الحاضر بالماضي، والحسابات الشخصية بالرؤى العامة.
ولا بديل من العودة للسياسة، من نقاش وحوار، وتنافس، في إطار مرجعيات وأحاسيس عامة، في الحياة العامة كلها، مع الحد الأدنى من الجدية، وسياسيين، حقا وفعلا، لم يقطر بهم السقف، أو جابتهم الموجة، بالتذرع بالحكمة الشعبية، ربيع السوق يترعى .المغرب يستحق أحسن من ذلك.
حسن أوريد
مستشار علمي بهيئة التحرير