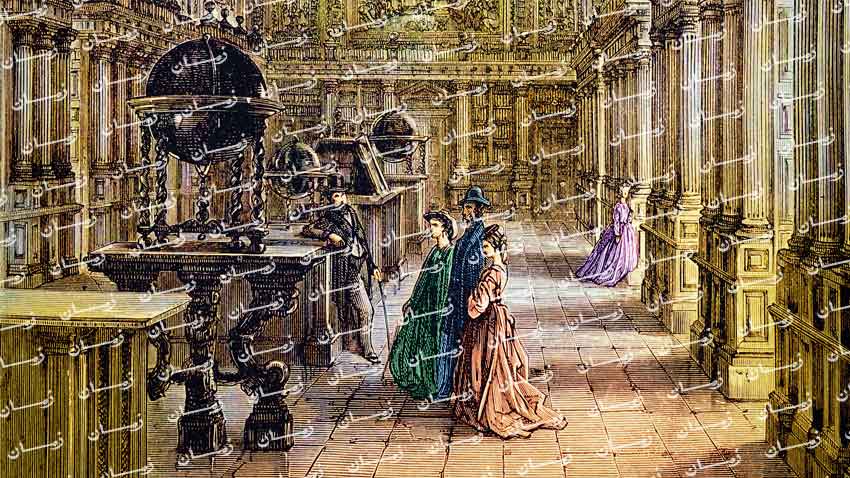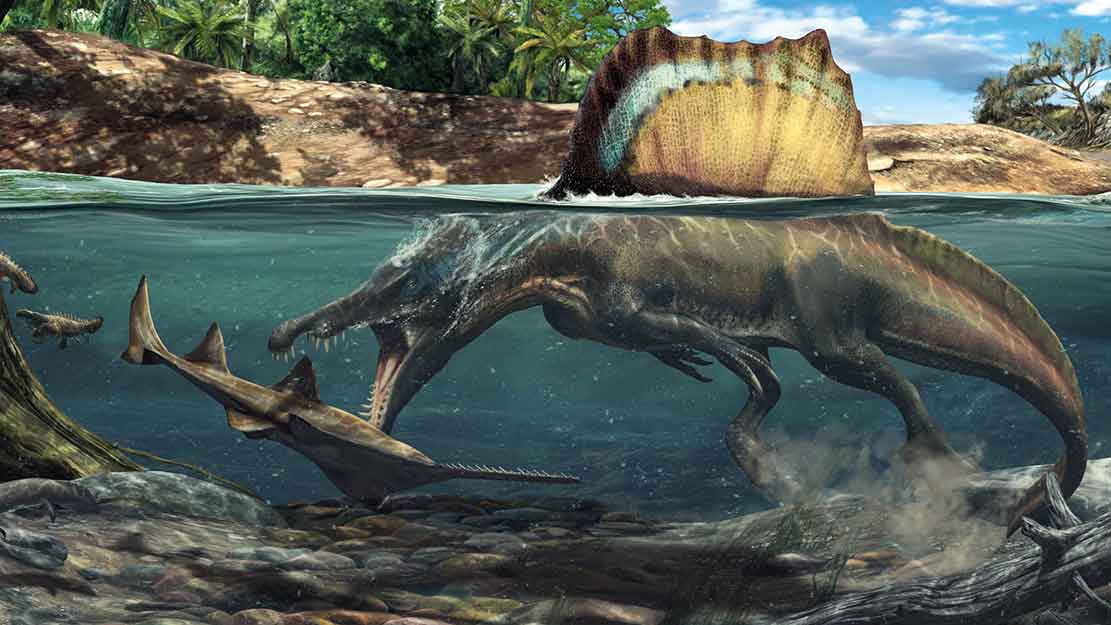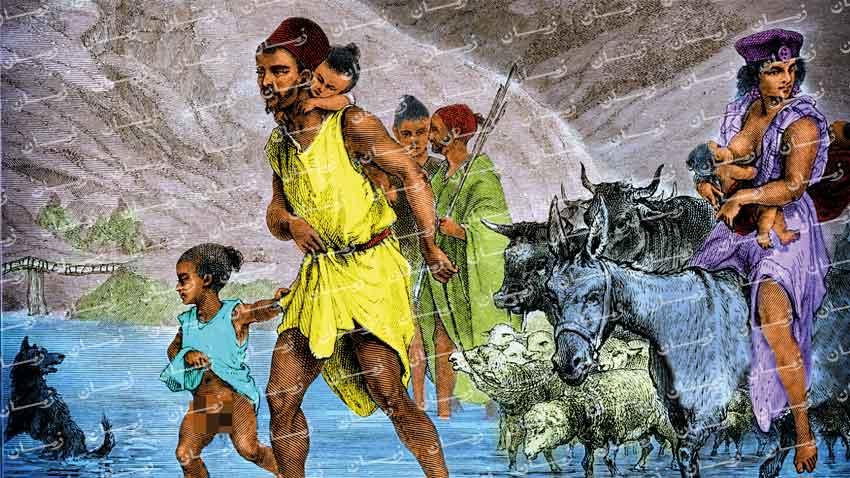منذ فترة تواترت قضايا سجالية توزعت فيها فعاليات المجتمع ببلادنا طرائق قِدَدا، كان منها الإفطار العلني، وكان منها عدم تجريم الممارسة الجنسية خارج قوالب الزواج، وكان منها إعادة قراءة التاريخ والنصوص المؤسسة، ومنها ما أثير مؤخرا حول موضوع إرث المرأة، أو على الأصح مساواة المرأة للرجل في الإرث. يمكن أن ننظر إلى المسألة نظرة اختزالية فننعت دعاة هذه الطروحات بالزيغ والفجور والطابور الخامس ونتوعدهم بالثبور وعظائم الأمور، ويمكن أن نذهب أبعد من ذلك فنكفّر أصحاب هذه الطروحات التي تريد أن تَشيع الفاحشة بين المؤمنين. ولكن ذلك لن يحل المشكل، ذلك أن هذه القضايا السجالية لن تتوارى، بل ستتعاظم، وهي مؤشر، على توزع مجتمعنا بين منظومتين، وربما يمكن الزعم بأن ما يسميه علماء الاجتماع بالوعي الجماعي الذي كان يشد لحمة المجتمع هو في طور التحول، وأننا نسعى إلى بناء وعي جماعي جديد لم تكتمل معالمه بعد.
كل مجتمع يقول على وعي جماعي مشترك يشُدّ لِحمته، ويحقق التوافق بين أعضائه، يقوم على الإيمان بقيم مشتركة، ويكون هذا الوعي الجماعي شاملا لأوجه الحياة في المجتمعات التقليدية، فينظم تلك الأوجه كلها، ويقل في المجتمعات المتقدمة ليتيح للفرد بمجال أرحب في شؤونه الخاصة. وما نعيشه هو أن الوعي الجماعي الذي كان يشد لحمتنا يتحلل، وأن البناء الجديد لم يكتمل بعد، وأن هذه الفترة تشهد صراعات وصدامات بين مرجعيات متضاربة.
من العبث الاعتقاد بأن قضية الإرث التي ُطرحت هي قضية معزولة، أو تهم جانبا وحيدا يدخل ضمن الأحوال الشخصية، فهي زاوية لتصور العلاقات الاجتماعية بعيدا عن وصاية الدين، وليس من قبيل الصدفة أن يأتي تصريح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السيد إدريس لشكر بالمساواة بين الإرث بعد مطالبة حزبه بدولة مدنية، وهي تورية لدولة تفصل بين الدين والسياسية. ومن القصور في الرأي الاعتقاد بأن تصريح السيد إدريس لشكر شطحة، أو فلتة، فهو يعبر عن شرائح عريضة في حزبه، بل من خارج حزب الاتحاد الاشتراكي، يلتقون حول الدولة المدنية، ولو أننا إلى حد الآن لم نتوصل بعد إلى تحديد دقيق لما نعنيه بالدولة المدنية. لذلك يخطئ أولئك الذين يعتقدون بأن المسألة يمكن أن تحل بتكفير فلان أو علان. نحن أمام اتجاهات اجتماعية وثقافية وسياسية، تتوزع بين مدارس فكرية وانتماءات سياسية معينة، وتلتقي حول قواسم مشتركة، وترى في الدين شأنا شخصيا، له دوره في تحديد الهوية الحضارية، والمرجعية الأخلاقية، ولكن لا ينبغي أن يُزجّ به في الساحة العامة، تقديسا له وتعظيما. المسألة لا تهم أفرادا “معزولين” أو”إمّعات”، أو”ساقطات”..
ظلت قضية الإرث الطابو، أو القلعة الصامدة في العالم العربي لم تزحزحها موجات التحديث، ففي الوقت الذي منعت فيها مجلة الأحوال الشخصية التونسية تعدد الزوجات مع بورقيبة، لم تستطع أن تمس مسألة الإرث، وظلت تركيا الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي ساوت بين الرجل والمرأة في الإرث منذ قانون الأحوال الشخصية الذي فرضه مصطفى كمال أتاتورك سنة 1929. قلت بأن المسألة لا تهم جانبا من جوانب الأحوال الشخصية. ومسألة الإرث أعمق وأعقد من مسألة تعدد الزوجات، التي ظلت في حكم الرخص والاستثناء، فالمطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث هي أبعد مدى، لأنها تنصرف إلى تصور للمجتمع وللدولة، ولذلك تستلزم تعاطيا هادئا ورصينا.
لقد أبدى الفقه الإسلامي أوجها من الاجتهاد سعت إلى أن توفق بين منطوق النص وروحه، أو مقاصده، بتعبير الفقيه الشاطبي، وحاولت أن تلتئم مع مبدأ العدل، هذا الذي يعد ركنا ركينا من مقومات الإسلام، ومنها ما أبدعه الفقهاء عندنا من سوس العالمة، من مبدأ الكد والسعاية، أي الاشتراك في الرأسمال المحصل بين الزوجين أثناء الحياة الزوجية، ومنها مختلف الحيل التي يعمد لها الآباء حتى لا تُبخس حقوق بناتهم وزوجاتهم..
ولا شك أن للاجتهاد الفقهي وجاهته، وهو دوما مطلوب، ولكنه يظل غالبا دون ما يتوق من ليس لهم مرجعية دينية. ومن الصعب حمل الاتجاهات ذات المرجعيات المختلفة على حلول وسطى. فالحلول الوسطى في قضايا ذات حمولة ثقافية أو دينية، هي السبيل لإغضاب الطرفين أو الأطراف. ما العمل إذن؟
هناك قضايا لا تحل من خلال المضاربات الفكرية، بل من خلال سيرورة التاريخ وتطور المجتمعات، أي أن عامل الزمن حاسم في حل القضايا الخلافية. يمكن للاجتهاد الفكري أن يسرّع في إنضاج قضايا أوحلها، أو الحد من تأججها، ولكنه لا يستطيع أن يبتسر ما لم ينضج بعد، وما لم تجد به “تاريخانية” المجتمعات، إن أردنا الحذلقة. فهل ننتظر عامل الزمن إلى أن يجود، ويتوزع مجتمعنا بين مرجعيتين متصارعتين يكيلان لبعضهما الشتائم والتكفير، ويفضي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه؟ ماذا لو أقررنا مرجعيتين في الأحوال الشخصية، مثلما نتعامل مع منظومات تربوية مختلفة. ماذا لو أقررنا مدونة مدنية، يختار الزوج والزوجة أن يقترنا بمقتضاها، ويتم تسجيلهما في السجل البلدي، ويحتكمان، بمحض إرادتهما لقانون يحرّم تعدد الزوجات ويجري المساواة في الإرث، ثم مدونة ذات مرجعية تقر تعدد الزواج، وتحتكم إلى أحكام الشريعة، فيما يخص الإرث بين الزوجين والأولاد… أليس من الأحسن أن يجري من له مرجعية إسلامية حياته الخاصة وفق ما يرتضيه، من غير تجزيء ولا تعسف في النصوص، أليس ذلك أدعى لأن يقبله من يسمى بالحداثي الذي قد لا ترضيه الحلول الوسطى ولا ما قد يراه فذلكات فقهية لا تشفي غليله، أليس هذا تجليا للدولة المدنية التي ترضي الأطراف كلها، تحترم ما يدخل في صميم “هوياتهم”، ولا تفرض عليهم تصورا لا يرضونه…
أعرف أن المسألة ليست بالسهولة التي يمكن أن نتصور، ولكن ألا تستحق النقاش؟ لقد وقفنا ضد التعدد الثقافي، وانتهينا بإقراره، فلم لا نقر بتعدد المرجعيات الفكرية فيما يخص الأحوال الشخصية؟
حسن أوريد
مستشار علمي بهيئة التحرير