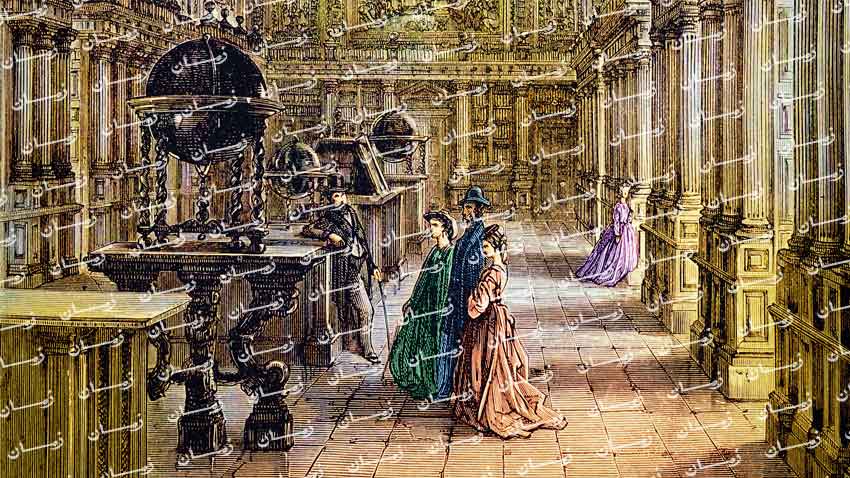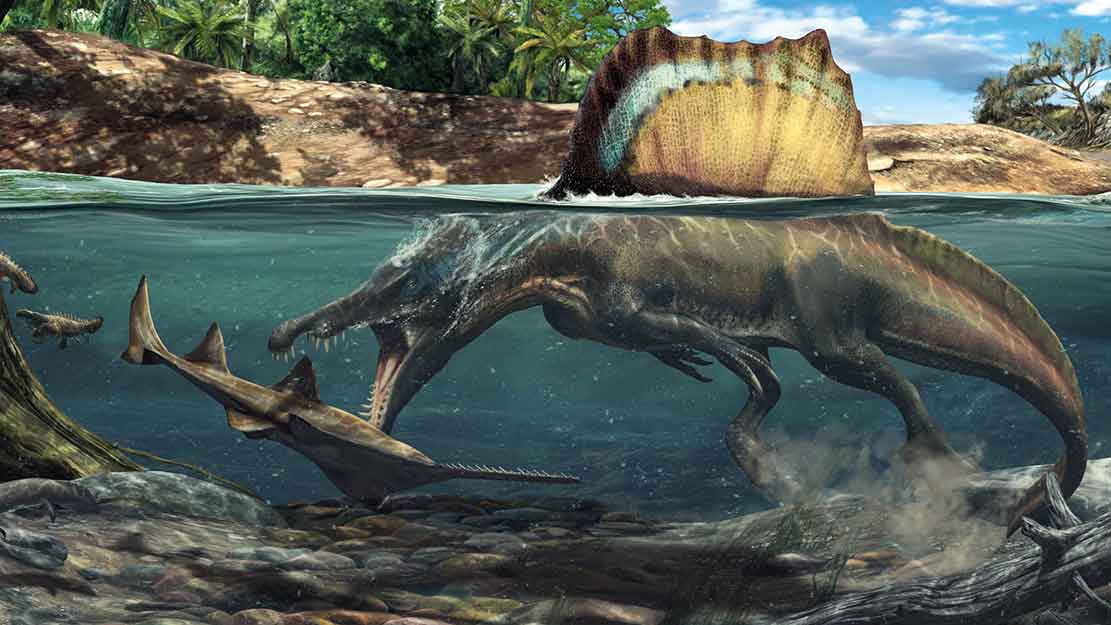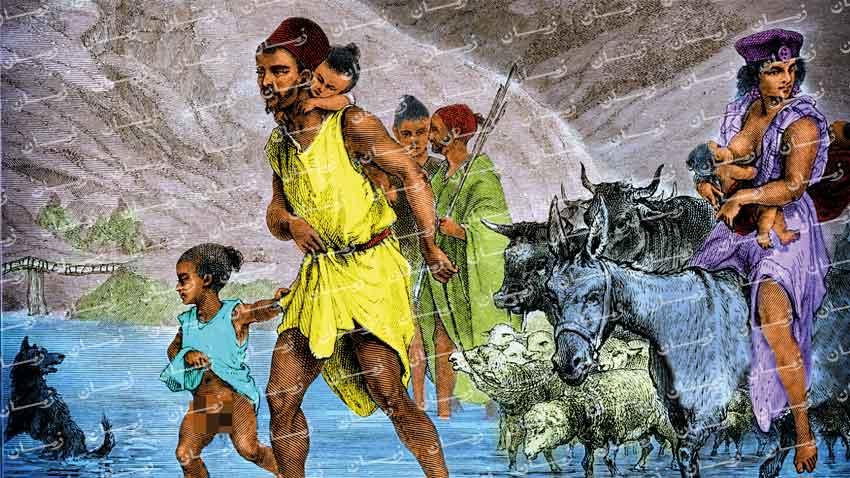بعد تسعة عشر سنة على وقوع أحداث 16 ماي الإرهابية، ما زال المغاربة يتوقفون عند هذا التاريخ من كل عام، لتذكر ما جرى وكان من تفجيرات مروعة وأحداث مؤلمة، أودت بعشرات الأبرياء، مما يعني أن الجرح ما زال لم يندمل بعد رغم مرور كل هذه السنوات، وأن كل هذه الأعوام التي مرت لم تكن كافية لتجاوز ما حدث في ذلك اليوم الأسود من تاريخ المغرب.
لن أعود مرة أخرى للحديث عن تلك الصدمة، وكيف اكتشف المغاربة صباح ذات يوم أنهم ليسوا بمنأى عن مثل هذه الأعمال، وأنه قد يكون بينهم قنابل موقوتة، تغذيها أفكار متطرفة وتصورات منحرفة، لكنني أود أن أقف بعد كل هذه السنوات مع السياسات الرسمية التي أفرزها هذا الحدث، وروعي فيها تجاوز الأسباب التي يمكن أن تكون سببا لكل ما حصل تلك الليلة. وأخص منها الحديث إعادة هيكلة الحقل الديني، وتنظيمه بما يسمح للدولة من القيام بوظيفتها في حماية الأمن الروحي والحفاظ على الاستقرار والأمان.
بعد أحداث 16 ماي ،2003 تنبهت الدولة إلى أن القطع مع الفكر المتطرف الذي أنتج هذه الأحداث، يقتضي إعادة هيكلة الحقل الديني، ومراجعة طرق تدبيره بما يسمح لها مراقبة الخطاب الديني وتوجيهه، بل وإنتاجه بما يتوافق مع القيم المؤسسة للتعايش والتسامح والتعددية والتنوع، فكان الظهير الصادر في 4 دجنبر 2003 في شأن اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيمها، والظهير الصادر في أبريل 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية، وتضمنت هذه المقاربة عددا من الإجراءات، كان من أهمها رد الاعتبار المؤسساتي لرابطة علماء المغرب، وتحويلها إلى “الرابطة المحمدية للعلماء“، وتجديد الاهتمام بمؤسسة دار الحديث الحسنية، وإحداث مجلس علمي للجالية المقيمة بالخارج، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي، وإطلاق قناة محمد السادس للقرآن الكريم، وإذاعة محمد السادس، والاهتمام بتكوين المرشدين والخطباء والمفتين وتأهيلهم.
من المؤكد أن هذه السياسة قد غيرت كثيرا من معالم الخريطة الدينية، ومنحت الدولة سيطرة على الحقل الديني، ومراقبة تامة له، مما جعلنا في حماية من الخطابات المتطرفة والانفلاتات التي كانت قبل ذلك، دون وجود أي آلية لردعها أو توقيفها .لكن هذا لا يمنع من القول بأن التطرف لم تقطع جذوره بعد، وهاجر مئات الشباب، بعد هذه السياسة، إلى بؤر القتال بالعراق وسوريا، وانتعشت في بعض الفترات خطابات التكفير، ورأينا في كثير من المحطات الأخيرة كيف أن خطابات الفتن والحشد والتحريض والتكفير ما زالت رائجة، وتجد لها جمهورا واسعا، وهو ما يعني أن منابع هذا الفكر ما زالت لم تجفف، وأن تربته ما زالت خصبة ويمكنها الاستنبات في أي لحظة.
صحيح أنه لا يمكن تحميل السياسة الدينية كل المسؤولية في القطع مع هذا الفكر، ولكن من المهم أيضا التذكير بأن هذه الهيكلة قد تم وضعها نهاية 2003 و2004، وكان التركيز فيها على مشاتل التطرف التقليدية كالمساجد الخاصة والمصليات الفوضوية، ولم يكن فيها توقع لما سيقع عامي 2005 و2006 من اختراع وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا “فيسبوك“ و“يوتوب“، وما أحدثا من ثورة في مجال نقل المعلومة والخبر، وما قدما من إمكانيات تم استثمارها بتفوق من طرف التنظيمات الإرهابية، والتي استغنت عن طرق الاستقطاب القديمة، وتحولت إلى هذه المنصات ليس للاستقطاب فقط، وإنما أيضا للدعاية والترويج والتواصل والتنظيم، مما وضع المؤسسات التقليدية في مأزق أمام هذا الإعصار المعلوماتي .ورغم بعض المحاولات المبذولة لتدارك الموقف، إلا أنها لم تتمكن برأيي في التواجد بقوة في هذه المنصات الجديدة، وهو ما سمح لمن أسميهم بـ“المتطرفين الجدد“ لتحويل خطاباتهم العنيفة من المسجد والخطبة والدرس إلى وسائل الإعلام الجديدة، التي ليس عليها لحد الآن أي أدوات للرقابة أو المتابعة باستثناء ما هو أمني.
لذلك، أعتقد، بعد كل هذه السنوات، أن هذه الهيكلة على ما كان لها من دور مهم في الحد من سريان الأفكار المتطرفة، تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، وتطوير الآليات والأدوات التي تسمح لها بمواكبة التغيرات التي يعرفها العالم، وبأن تكون أسبق إلى التواجد والتأثير ونشر الأفكار، لما فيه مصلحتنا جميعا في العيش بوطن آمن متعدد ومستقر.
محمد عبد الوهاب رفيقي
كاتب رأي