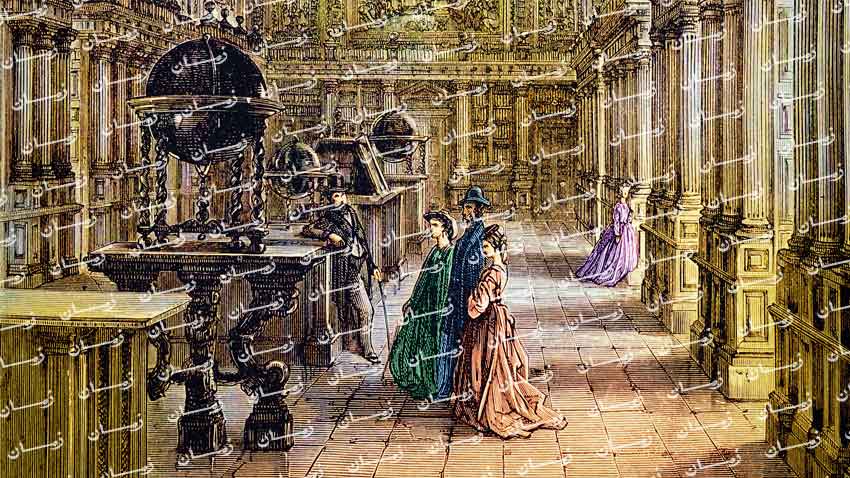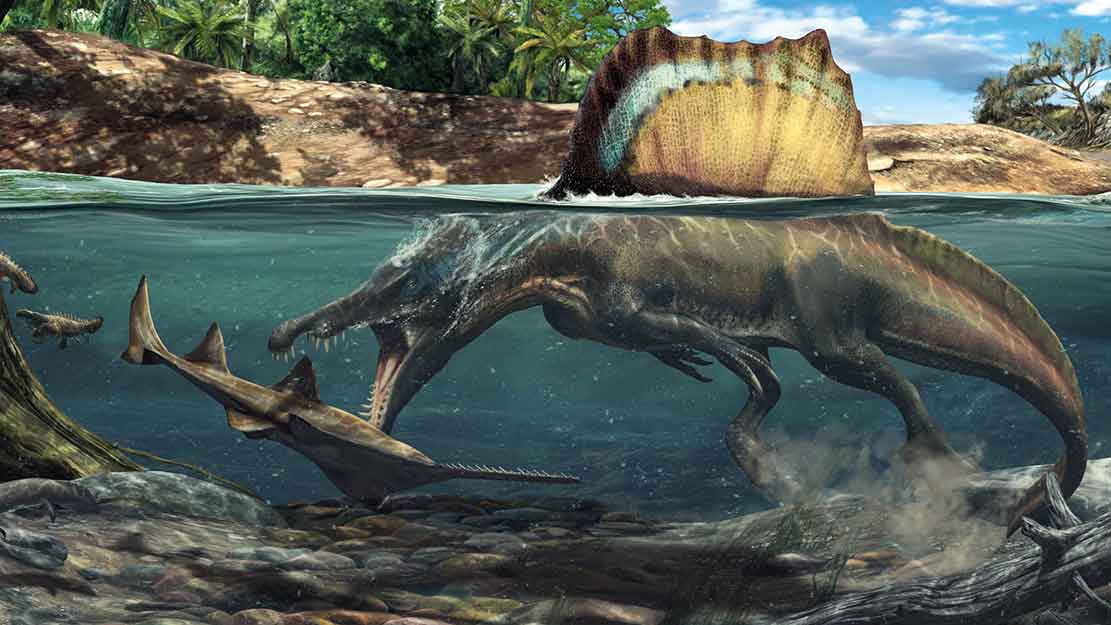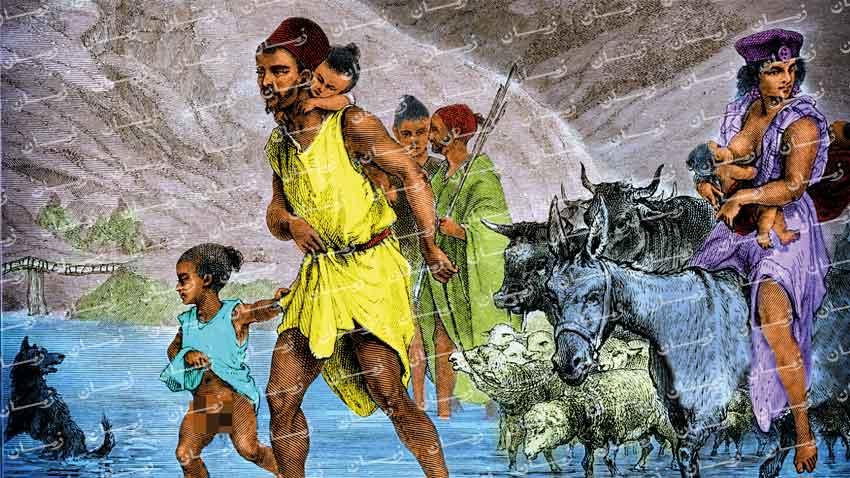أنظر هذه الأيام في المرآة، وأحملق في وجهي، ثم أتساءل هل صرت إسلاميا، وأحدق فيّ مليا، وهل نبتت لي لحية، ثم أتشممني حتى يطمئن قلبي، فأشكر لله، أن لا رائحة مسك في ثيابي، ولا أجرؤ أن أسأل أحدا، إن كان قد انتبه إلى أمري، وإلى ما يغلي بداخلي.
وكي أكون صريحا، فإنه، ومنذ مدة ليست بالقصيرة، أصبحت ألاحظ علي ميولات غريبة، ودون أن أدري كنت أجدني مدافعا شرسا عن عبد الإله بنكيران، ولم أكن أترك الفرصة تفوتني دون أن أتفرج فيه، وأضحك، وأشمت في خصومه، وهو يسقطهم الواحد بعد الآخر.
ولست متأكدا هل مسخت، أم ما زلت كما كنت، شخصا غير محترم، وسمعتي في الحضيض، وأخلاقي منفلتة، فأراقب تصرفاتي، فأجدها هي هي لم تتغير، وما كنت أفعله في الماضي، ما زلت أفعله اليوم، وحينها فقط أطمئن، ويهدأ بالي، إلا أن نفس الوساوس، تنتابني من جديد، و أرى أني قريبا سأصبح منهم، فيتملكني الفزع، وألجأ إلى استعمال الكلام الساقط، وأتعرى، وأدخن السيجارة تلو الأخرى، وأمنع قناة الجزيرة في البيت، وأعادي الإخوان، وكل هذا كي أنفي عني التهمة، وأكذب ما يحصل لي.
صحيح أني لم أعد يساريا، لكني كنت على وعي بذلك، واخترت عن قناعة أن أصبح يمينيا، ولم أشعر بأي حرج وأنا أفعل ذلك، بل كان تصرفي طبيعيا، ومواكبا للواقع، من وجهة نظري، كما أن هذا التحول قديم، ولا علاقة له بالإسلاميين، ولا بما يقع لي الآن، وقد كنت أتخيل كل شيء، إلا أن أصبح واحدا منهم، ومتأثرا بأمينهم العام.
ورغم أن الأمر لم يصل بي إلى أن أرفع شارة رابعة، ولا إلى أن أترك كل المآسي التي بالقرب مني، وأكتب “عذرا بورما”، ومع ذلك فقد خفت أن تكون هذه هي خاتمتي، وأن تحولي لا راد له، وبعد حياة كلها نزق، وميوعة، وتفسخ، ينتهي بها المطاف بينهم، أشرب اللبن، وأستيقظ في الفجر، وأنصح الناس، وأبين لهم الطريق، وأميط عنها الأذى.
وقد بدأت أشعر بهذا الخطر منذ سنتين أو أكثر، واقعا تحت سحر عبد الإله بنكيران، ودائما كنت أقول إنها نزوة وستمر، والمسألة ليست جدية، وأعترف أني بصعوبة منعت نفسي من التصويت للعدالة والتنمية في الانتخابات الماضية، فكنت أوبخني، وأنهرني، وأحتج علي، وأشتمني، وأقول عني يا ظلامي، وأعير نفسي أنه ليس في القنافذ أملس، وأهجم علي، وأقاطعني، لكنه، ورغم كل المقاومة التي أبديتها تجاهه، ظل يرغمني على الوقوف في صفه، ويجذبني نحوه.
ولا أنفي أني خفت، إذ ليس لائقا أن أقضي ما تبقى لي من عمر إسلاميا، فمن طبعي أني لا أغض البصر، وأجد متعة في النظر إلى كل ما هو جميل، وأتلصص كلما بدت لي فجوة، أو كوة ضوء، كما أني أنفر من ذوقهم، ومن هندامهم، و أتخيلني مضحكا وأنا معهم بالفوقية، فأسخر من منظري، وأخشى أن يضبطني أصدقائي، كما لا أتصور يوما أني سأشتري ذلك السروال العجيب الذي اشتراه بنكيران من أمام المسجد، وقامت حوله القيامة، وكتب عنه المحللون، أما عطورهم، فإنها تصيبني بالدوخة، ولا روايات لهم لأقرأها، ولا شعر، ولا سينما، ولا غناء، ولا رقص، ولا إغراء، ولا سهر، وعندما أستيقظ ينامون، وقد أستفيد منهم، ومن صعودهم، وقد أنجح معهم، لكن أي نجاح هذا، وأنا ممنوع من الحركة، والعيون تراقبني، وتحصي أنفاسي، وتلزمني بمكارم الأخلاق، وتمنعني من دخول كل الأماكن التي تعودت الدخول إليها. ولم أرتح حقيقة، إلا بعد أن ذهب بنكيران، وانتهى الكلام، وبعد أن صوتوا في حزب العدالة والتنمية ضد منحه الولاية الثالثة، وحسنا فعلوا، لأن كثيرين وقع لهم ما وقع لي، واستسلموا لجاذبيته، ولم يدروا إلا وقد أصبحوا كاملي العضوية، ويعتبرونه أملا للإصلاح في المغرب، و دليلا نادرا على وجود حياة سياسية سليمة في هذا البلد.
ولولا حرص السلطة في المغرب على التنوع، ولولا يقظتها، ولولا الأحزاب التي انتبهت إلى الخطر الذي يشكله بنكيران في استمالة أشد المعارضين لخطه الإيديولوجي، والذين اتحدوا جميعا للتخلص منه، بمساعدة من العدالة والتنمية، حفاظا على بيضة الحزب، وحتى لا يخترق تنظيمهم سيئو السمعة من أمثالي، لصرت إسلاميا، ولصار كثيرون من أمثالي، أعضاء بارزين في هذا الحزب، ويصوتون له، ولأصبح حزبهم بلا توجه واضح، ويضم اليساري والعلماني والحداثي والليبرالي، وكل الإصلاحيين، الذين فقدوا البوصلة، وفقدوا أحزابهم التي كانوا يعولون عليها، وفقدوا أشخاصا يمثلونهم، وفقدوا الأمل.
أما الآن، وبعد أن تم طرده، وبعد أن اكتشفوا نزعته الاستبدادية، فإني أنظر في المرآة، ولا أرى إلا وجهي القديم الذي تعودت عليه، بعد أن زال الخطر، وزال السحر، وانتهت هذه الظاهرة، التي جعلت أشد خصومها ينتبهون إليها، ويتعاطفون معها، ليعود كل واحد منا إلى المكان الذي جاء منه، وإلى أسرته، وإلى يأسه السابق، كأن شيئا لم يحدث، ولنبدأ من جديد من نقطة الصفر.
حميد زيد