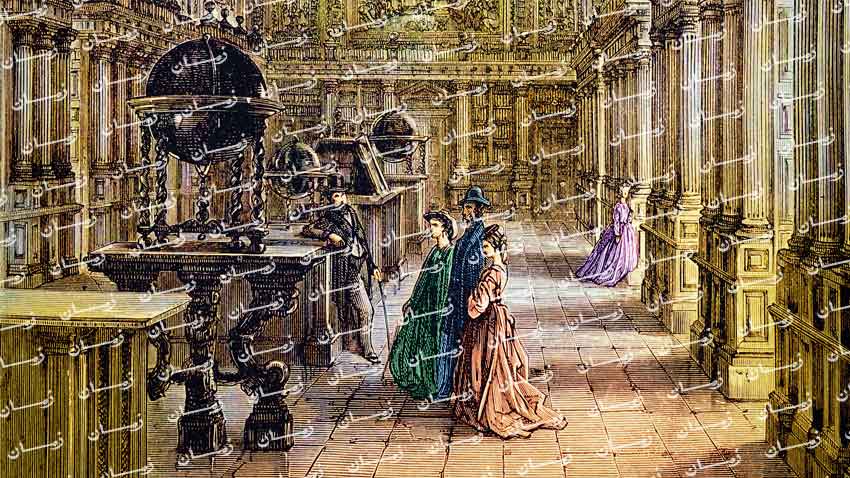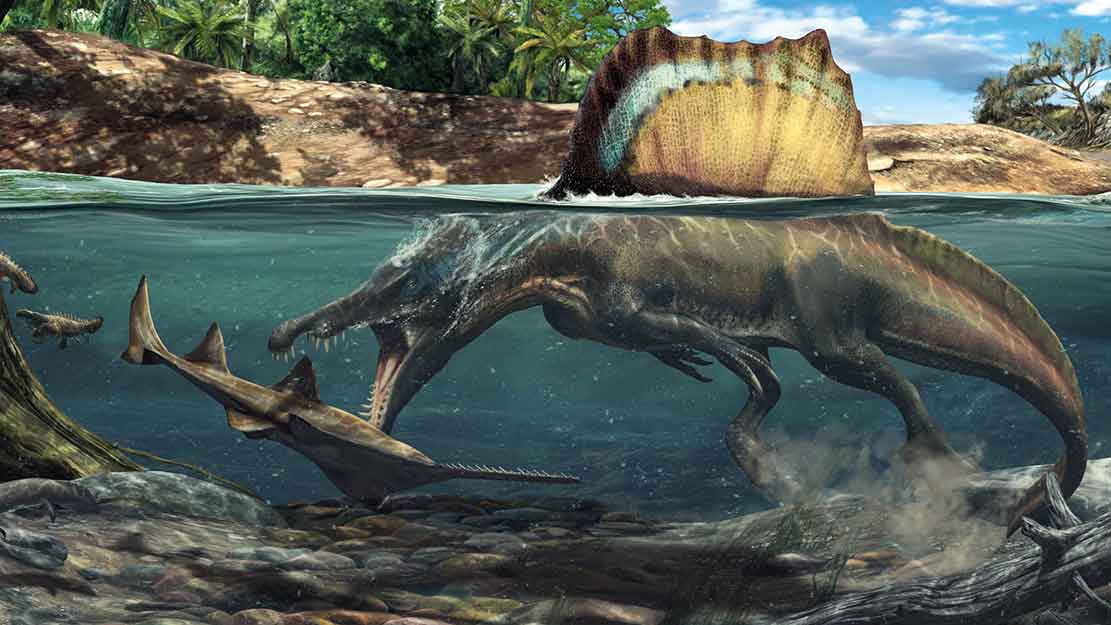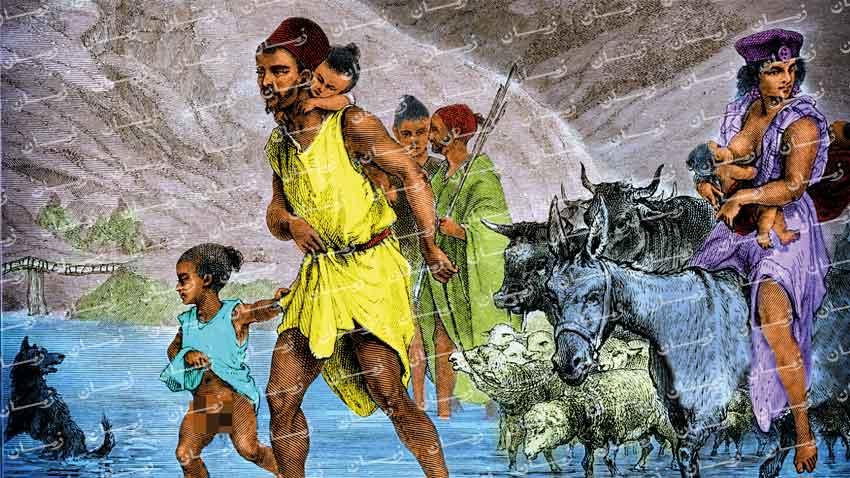هو ذا السؤال الذي طرحه الصحافي عبد العزيز كوكاس في مقال عميق بعنوان النهضة العربية الرابعة، غار فيه كاتبه في تجاويف التاريخ العربي المعاصر، وقام بعملية مسح لمناراته الفكرية التي حملت أملا وتصورا، مثلما وقف على انكساراته، ووقف عند الرؤية التي حملها الأكاديمي الأردني مروان مَعشّر (الذي سبق له أن شغل منصب وزير خارجية لبلاده) والذي يشتغل في مؤسسة كرانغي الأمريكية للبحث، في كتابه “اليقظة العربية الثانية“. وللعنوان قصة، لأنه يستوحي كتابا صدر في الثلاثينات من القرن الماضي، للكاتب الأمريكي من أصل لبناني جورج أنتونيوس “اليقظة العربية“، وهو من أمهات الكتب إن صح هذا التعبير، لا غنى عنه لفهم مسار العالم العربي، والوقوف على تلك المرحلة الحبلي بالآمال مع ما سمي بالثورة العربية التي حملها الأمير فيصل (الهاشمي). ويستشهد الكاتب، في صدر الكتاب، ببيت للشاعر ابراهيم اليازجي، بل وينقله باللغة العربية، مع أن الكتاب كتب بلغة إنجليزية رشيقة.
تنبّهوا واستيقظوا أيها العرب // فقد طمى الخَطْب حتى غاصت الرُّكَبُ
ولأزمة العرب، يقول مروان مَعشّر، ملمحان، نهضة حملتها، في يقظتها الأولى، صفوة (أو نخبة) من دون جماهير، ويقظة جماهير من دون صفوة، في زمنها الثاني، هذه الذي اقترن بما سمي بالربيع العربي ولحالة الاحتقان، يشفع مروان معشّر، مخرج، يسميه بالطريق الثالث، يقطع مع التنظيمات الاستبدادية وتنظيماتها الموالية، ومع الحركات الإسلامية التي هي رد فعل للاستبداد وتنظيماته المتحلقة حوله، من أجل اتجاهات تؤمن بالتعددية سواء أكانت عقدية أو سياسية أو ثقافية، وتدبير الاختلاف بالطرق السلمية، وترتبط بالجماهير. يعترف مروان معشر بتجذر الحركات الإسلامية، وتغلغلها في المجتمع، مثلما يقر بأنها تجني ما غرست لعقود من العمل الدؤوب والمثابرة، وصمودها أمام المضايقات وصنوف البلاء والمحن.
إذن، فليس هناك طريق سالكة لخيار ثالث. وليس هناك من حل جاهز، بل عمل دؤوب، يتطلب طول النّفس، والرَّوية، والرؤية، والتضحية، والقرب من الجماهير، لتجاوز إصر الاستبداد، وضيق أفق الحركات الإسلامية.
ويظل المشكل الأكبر، هذا الذي ألمع له معشر، غياب الصفوة…
طبعا، يحتاج الأمر أن يجري بعض التمييز، فليس معناه أن هذا العالم لم ينتج أشخاصا متميزين ولا هو عاجز عن ذلك. كلا، تظل الكفاءات الفكرية معزولة عن ميكانيزمات القرار، مفصولة عن الجماهير، لأسباب موضوعية. يفضل أصحاب القرار أن يستهلكوا “فكرا“ جاهزا، يأتي من لندن أو واشنطن أو باريس. وتفضل الجماهير مَن يدغدع مشاعرها بما تهواه النفس. ومع ذلك، يمكن أن نقف عند انحسار النّتاج الفكري في قضيتين أساسيتين لهما تداعيات خطيرة (مهمة جدا). أولا الاقتصاد، فالعالم العربي لم ينتج فكرا أصيلا أو مساهمة تذكر ما في هذا الميدان، حيث يظل الاقتصاد من حيث الممارسة ريعيا، والتقاطيا من حيث التنظير. فلم يُقدّم العالم العربي أي رؤية أصيلة حول الإشكاليتين الكبيرتين في الاقتصاد، وهما العلاقة ما بين الرأسمال والعمل، ثم إنتاج الثروة وتوزيعها. ظل العالم العربي موزعا بين من كان يستقي تقنياته من التجربة السوفيتية، وكَسَد بكسادها، ومن كان يقتفي أثَر إملاءات المؤسسات المالية، ويجني الآن ثمار زيغها، ثم أولئك الذين أفاء الله عليهم من فيئه، يوم أن أخرج “الكفار“ ما في بطن الأرض، وهم الآن بصدد التحول عنهم. وقد سبق للمرحوم أبراهام السرفاتي، في مقال بـ“لومند دبلوماتيك“ في بداية التسعينات، أن هزأ من اقتصادي مغربي مرموق، برّر ما لا يُبرَّر، باسم الواقعية المستقبلية ،Le Réalisme Prospectif وكان أن انتقل من الاشتراكية إلى الليبرالية الجديدة، و زعم أن يمتص البطالة ورعى مؤسسة للشباب من أجل ذلك. والنتيجة تُحدّث عن نفسها بنفسها .ولو نظرنا إلى بلدان صغيرة مثل فلندا، لرأينا أنها أنتجت رؤية خاصة بها في الميدان الاقتصادي، بل إن بلدا فقيرا مثل البيرو قدّم اقتصاديا مرموقا، له رؤية نقدية للبرالية المتوحشة، دون أن يعارض نظام السوق هو Hernando De Soto وأما الإشكالية الكبرى التي لم يبدع فيه العالم العربي، فهي التربية، باستثناء كتاب يتيم هو “مستقبل الثقافة في مصر“ لطه حسين. ذلك أن التربية تقترن في الغالب بالتعليم وليس صياغة إنسان جديد. ونتائج التعليم، كمّا ونوعا، تغني عن كل بيان. من أسباب المشكل، طبعا، انصراف اهتمام العالم العربي إلى القضايا الأمنية. إلى التسلح، لأنه ورث تقسيمات للحدود ملغومة، وإلى رعاية أجهزة أمنية مُكلّفة، لأنه لم يستند على شرعية ديمقراطية، وذلك لضبط الديناميات الداخلية. أضحت الأجهزة الأمنية مؤسساتٍ سياسيةً فعلية. وعوض أن يستثمر العالم العربي في الفكر والبحث والإبداع، صرف أمواله في الثكنات والأقبية وأجهزة التصنت، وثقافة المؤامرة والكذب و الوشاية والتلفيق، وانطبع المجتمع بذلك، وأضحى الخوف عنده جِبلّة، أو طبيعة ثانية، ورديفه الفوضى.
لعل التاريخ أن يفيدنا. كانت أوربا ممزقة في القرن السابع عشر تنخرها الحروب الأهلية، والصراعات الطائفية والنزاعات الدينية، وتوقف قادتها في قرية ببروسيا (ألمانيا الحالية) هي ويستفاليا سنة ،1648 وأرسوا منظومة جديدة، تقوم على بنية الدولة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ووضعوا القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها إلى الآن. لا بد للعالم العربي من ويستفاليا: من أن يضع السلاح والريبة جانبا، ويرسي قواعد جديدة في تدبير العلاقات العامة، وأن تصبح الدولة، عقدا اجتماعيا. ذلك أن الدولة، مثلما كتبت صحيفة “ذوإكونومست“ في عدد خاص عن العالم العربي في يوليوز ،2014 هي الغائب الأكبر في العالم العربي حيث تقوم أنظمة قوية، ودول هشة.
يقول المؤرخ المغربي عبد الله العروي: «من خرج من التاريخ لا يعود إليه. لست أدري، ولكن هناك خطرا محدقا أشد ضراوة يتربص بالعرب هو أن يخرجوا ليس من التاريخ وحده، بل ومن الجغرافية».
ينوء العرب من ماض لم يمض كما يقول ألان كريش. لا يتحملون المسؤولية كاملة فيما جري، ومسؤوليتهم كاملة للخروج من وضع الوهن الذي يرين عليهم .فهل يحققون وسيتفاليا تنقلهم من طور لآخر؟
حسن أوريد
مستشار علمي بهيئة التحرير