أثار موضوع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب سجالا واسعا في الآونة الأخيرة، وتباينت الآراء بشأنه، بين من رأى فيه ترياقا ضروريا وغير قابل للتأجيل، حتى لا يستفحل الوضع أكثر، رغم الإقرار بمرارة هذا العلاج المقترح، وبين من رأى أنه من غير العدل أن يؤدي المواطنون ثمن أخطاء في التدبير ليسوا مسؤولين عنها. وإذا كانت غايات وآليات الإصلاح قلما تكون موضوع إجماع، بسبب تفاوت التقديرات حينا وتضارب المصالح أحيانا أخرى، فإن النقاش الحالي حول التقاعد والمعاشات وإنقاذ الصناديق المفلسة، لا يمكن عزله عن فكرة الإصلاح كما ظهرت في المغرب المعاصر، وكيف جرى تمثلها والسعي لأجرأتها.
خلخلت هزيمة المغرب في معركة إيسلي سنة 1844 اطمئنان الذات، وفرضت مراجعة مجموعة من المسلمات واليقينيات المستوحاة من انتصارات سابقة، كان أبرزها نصر واد المخازن. فبدأت تطفو على السطح دعوات للمراجعة والبحث عن أسباب الوهن، خاصة بعد الصفعة الثانية في حرب تطوان سنة 1860، الذي أزالت حجاب الهيبة وعرت المستور. غير أن منطلق المراجعة، والذي سيسم ما بعده من مبادرات إصلاحية، ظل محكوما بخلل مزدوج اعتوره منذ البداية، فهو من جهة اختزل فهمه للعطب في ما هو تقني، لذلك ركز على الإصلاح العسكري أكثر من تبنيه لمشروع إصلاحي متكامل، ومن جهة ثانية جاء، في الغالب الأعم، بمهماز خارجي وتحت ضغط القوى الاستعمارية المتهافتة للسيطرة والنفوذ، أكثر من إرادة ذاتية بعد طول اختمار. وبين النظرة المجتزأة للإصلاح وتوجيهات القوى الأجنبية، وربما بسببهما معا، حضر التوجس من كل تغيير غير مأمون العواقب، والذي اختزلته مقولة: “إبقاء الأمور على عوائدها حتى لا يتسع الخرق على الراتق”.
دشن السفير البريطاني جون دراموند هاي “عراب الإصلاح” بمغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مبادراته بوصفة “إصلاحية”، فرضها بالقوة سنة 1856، خلخلت التوازن الاقتصادي للبلاد، بعد إقحامه القسري في منظومة رأسمالية لم يكن قادرا على مجاراتها. ولما استفحل الوضع المالي أكثر، خاصة مع تزايد الأجانب والمحميين بالبلاد، سعى السلطان الحسن الأول إلى تدارك الموقف بإصلاح ضريبي خرج من رحم مؤتمر مدريد سنة 1880، لكن مسعى تعميم الأداء الجبائي المنشود من خلال هذه المبادرة السلطانية حالت دونه عقبات ذات طابع بنيوي، نسفته من أساسه. وعندما حاول السلطان عبد العزيز إحياء مبادرة والده بجرأة أكثر مع مطلع القرن العشرين، تمت عرقلتها من الخارج، لجره إلى مستنقع الاقتراض، ومهاجمتها من الداخل بدعوى أنه نسخ الزكاة الشرعية بالترتيب، وجرى اعتبارها من طرف الأوساط المحافظة إحدى الزلات المبررة لخلعه. خاب أمل فرنسا في فرض حمايتها على المغرب مع نهاية سنة 1904، تحت يافطة برنامج سان روني طايندي الإصلاحي، فأسقطت القناع عن مراميها الحقيقية منذ البند الأول من معاهدة الحماية الموقعة يوم 30 مارس 1912، الذي أرادته أن يعلن عن حصول اتفاق على ” تأسيس نظام جديد بالمغرب، مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية، التي ترى الدولة الفرنسوية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية”. وبين مسعى ليوطي لإضفاء بصمته الخاصة على هذه الإصلاحات، وسعي إيريك لابون للعب ورقة الإصلاح في زمن المطالبة بالاستقلال، تباينت التقديرات إزاء الحصيلة سواء على المستوى التحديث أو الحداثة.
دشن المغرب المستقل مرحلة ما بعد الحماية بجملة من المشاريع الإصلاحية، أبرزها الإصلاح الزراعي، وتوالت طيلة مرحلة الستينات والسبعينات الأفكار والمبادرات الإصلاحية التي همت مختلف الميادين، واختلفت التقييمات بشأن نتائج هذه الإصلاحات، والمستفيدين الفعليين منها. بيد أن منتصف الثمانينات طبع على تحول مهم في هذا المسار بعد أن دخلت المؤسسات المالية المانحة على خط التوجيه الإصلاحي، من خلال وصفة التقويم الهيكلي، فأطل التوجيه الأجنبي برأسه من جديد، وبقوة جعلته يفرض ما يراه هو أيضا نافعا، ويضعه شرطا إلزاميا لتقديم قروضه للمغرب.
همت مبادرات ومناظرات الإصلاح مختلف القطاعات، وظل التأثر الخارجي حاضرا. مما يعني أن ورش الإصلاح مفتوح ومتجدد، ويمكن أن يسهم فيه الجميع، خاصة حين يتم الحسم مع التردد، ويجري الانتقال من تأثير للخارج عبارة عن وصفات تفرضها المؤسسات المالية إلى الاقتداء بتجارب رائدة في الإصلاح، مثلما حصل مع دول انتقلت من التبعية إلى تحقيق الفائض وليس فقط الاكتفاء الذاتي. ذلك أن أحد أهم مداخل الإصلاح يرتبط بإستراتجيتي الاستثمار في الرأسمال البشري كرافعة للتنمية، وتجاوز منطق في الإنتاج يقوم على مقارنة التكلفة محليا في علاقتها بأسعار السوق العالمية.
فهذه الأخيرة متغيرة ومتقلبة ومحكومة بمنطق العرض والطلب والمضاربة، كما حصل مع أسعار الحبوب منذ 2008، وكانت التداعيات مكلفة جدا. إذ من الصعب تصور تحقيق الإصلاح وحصول التنمية بينما الأمن الغذائي والأمن الطاقي غير متحكم فيهما محليا، والنظام التعليمي لم يستقر على قرار، وكل إصلاح فيه يجب ما قبله، والهاجس التقني محافظا على صدارته ضمن سلم الأولويات.
فالإصلاح ليكون عميقا لا يفترض فيه أن يحكم بالظرفية دون أن يلتفت للبنية، ولا أن يرتهن لانتظارات اللحظة ويغيب الأفق البعيد، ولا أن يكون تحت ضغط الخارج، غير مكترث بما يعتمل في الداخل، ولا أن يختزل في التقنوي، مستنكفا عن المنهج الشمولي، حتى لا تتكرر تجارب وتهدر طاقات دون إنجازات.
الطيب بياض
مستشار علمي بهيئة التحرير

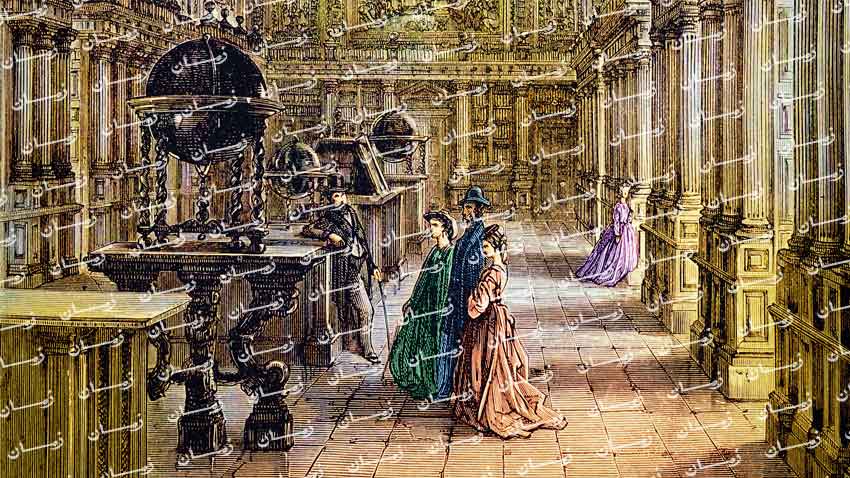







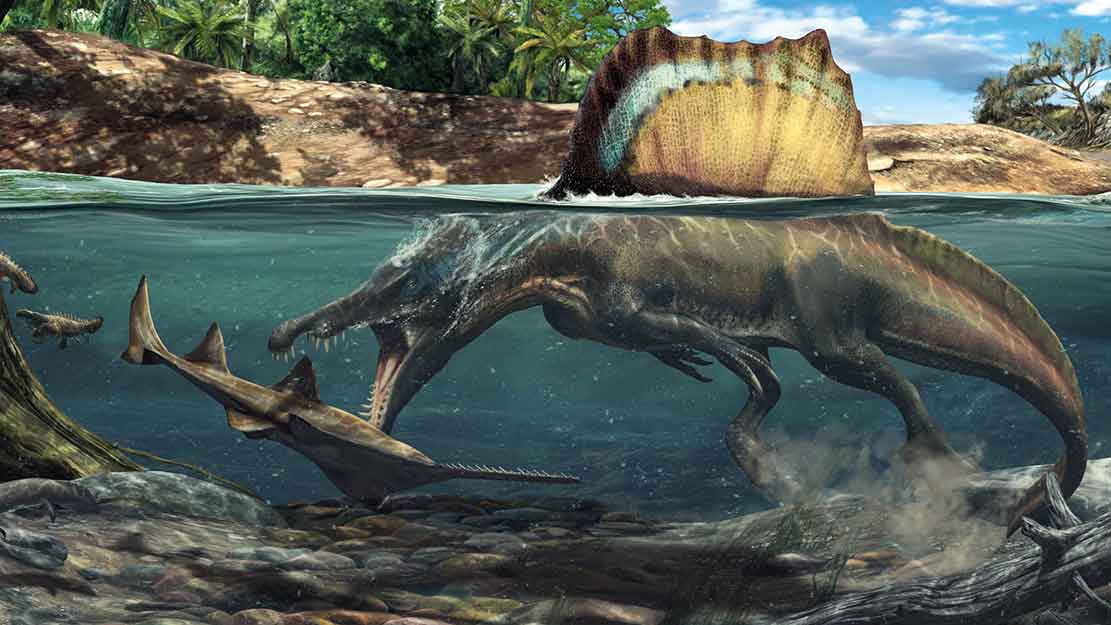






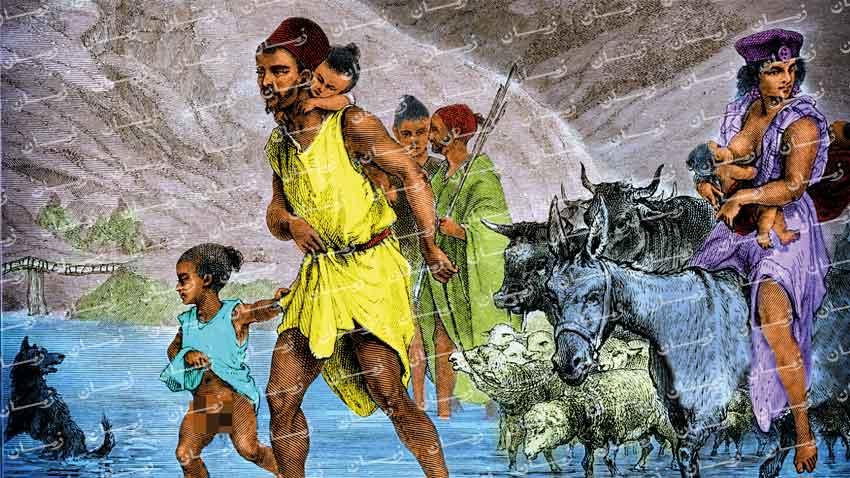






























احتراماتي الأستاذ الكبير الطيب بياظ
يوحي الموضوع من خلال مقدمته التي تطرح الأشكال المفروض معالجته في المقال إلى راهنيته لذلك حبذا لو ارتبطت بهذه الراهنة وحبحكت موضوعا لايبارحها خاصة وأن الضروف السياسية تختلف بشكل كبير بين فترة المشكل المعالج والتأصيل التاريخي للداء