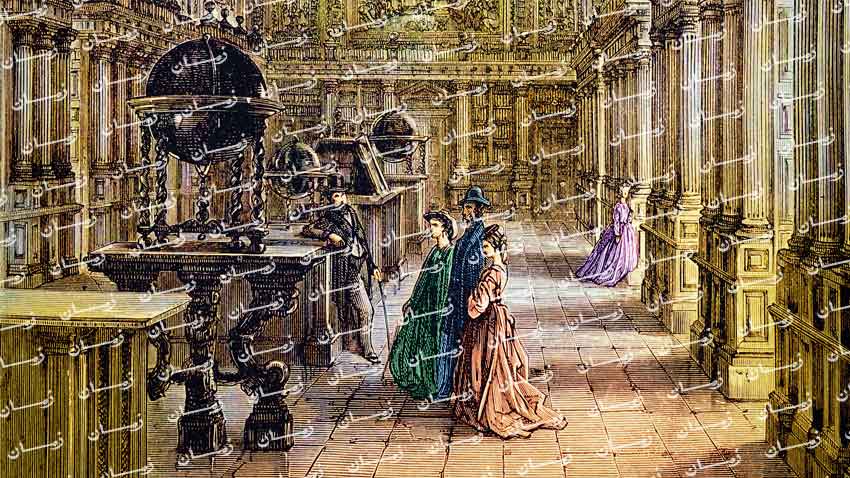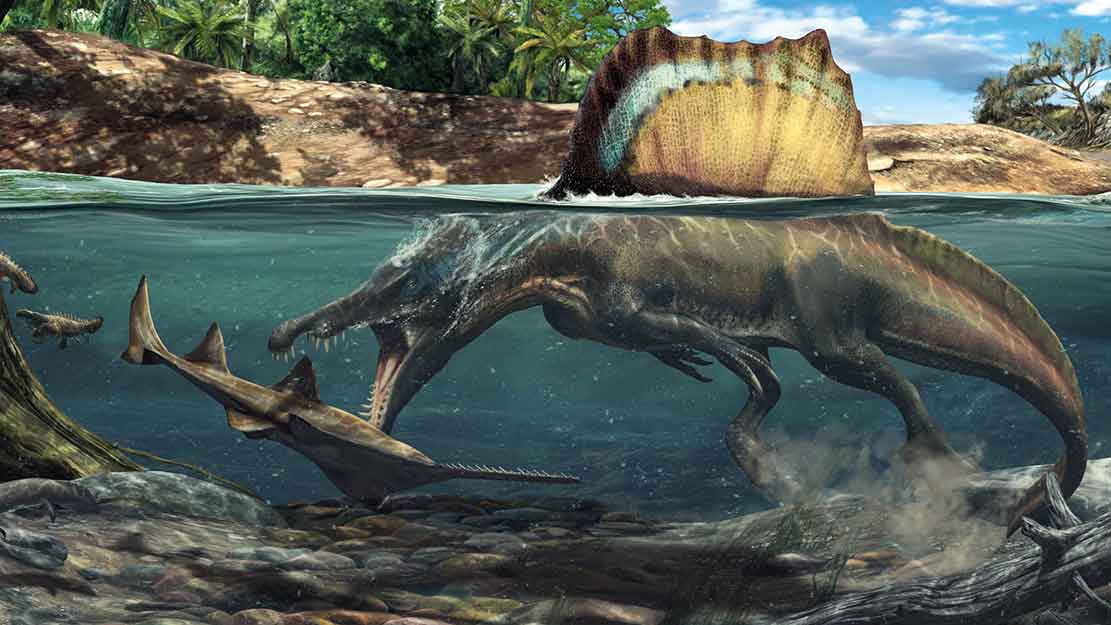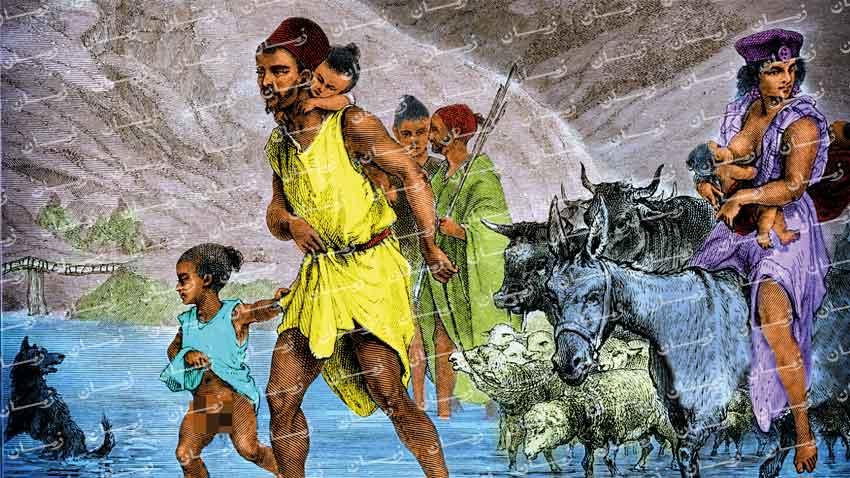كانت علاقتي به وأنا طفل طيبة جدا، فقد كان كثير المرور من أمام بيتنا بسيارته، قادما من الرباط إلى الدار البيضاء، أو عائدا إلى العاصمة، أو مدشنا، أو قاطعا لشريط.
وفي كل مرة يمر فيها، كان مدير المدرسة يتجول على أقسامنا، قسما قسما، ليخبرنا بالموعد، وليؤكد لنا أننا، وفي اليوم المحدد، سنكون في عطلة، من أجل استقبال الملك.
لم أكن في ذلك الوقت أحب المدرسة، وبصريح العبارة فقد كنت كسولا، فيأتي الملك الراحل الحسن الثاني، وينقذني من معلمة اللغة الفرنسية الشريرة، التي كانت تقرص لحمنا الطري، وتضربنا بقضيب على أصابعنا، وترغمنا على الحديث معها بلغة لا نفهمها، في سنوات رصاص المدرسة المغربية. كنا نتكدس في الرصيف، منذ الصباح الباكر، مشرئبين بأعناقنا، ننتظر مروره، فيمضي الصباح، وتمضي الظهيرة، ويضربنا رجال القوات المساعدة، وتضربنا الشمس الحارقة، ونحن سعداء، نغني للملك، شاكرين جلالته على العطلة التي منحها لنا.
وأتذكر مرة أنهم هيأونا في المدرسة لاستقباله، فقضينا أياما نحفظ الأناشيد، ثم طلبوا منا أن نحمل معنا في اليوم الموعود سندويشا وماء من البيت، وقد كان الأمر ممتعا حقا، وأشبه برحلة مجانية، وفرصة للعب وللتخلص من قسوة المعلمين.
وكعادتنا خرجنا في الصباح الباكر، فوجدنا مئات الأطفال قد سبقونا، ومر الصباح، ومر العصر، وحل المساء، لكن الملك لم يظهر، ولم يلوح لنا بيده، ولم يمر موكبه، إلى أن فقدنا الأمل، فعدنا أدراجنا إلى منازلنا، وفي المنزل وجدناه في شاشة التلفزيون، وتفرجنا في الملك في حينا، يحمل ملاّسة بيديه الكريمتين، ويملس حفرة صغيرة بالإسمنت، أخبرنا المذيع في نشرة الأخبار أنها هي الحجر الأساس.
لم نستوعب في ذلك الوقت السبب الذي جعل الملك الراحل يخلف موعده معنا، ويختار طريقا أخرى ليمر منها، رغم أننا تهيأنا للحدث، وحفظنا الأناشيد التي تبددت في الهواء، والتهمنا السندويشات، وتلقينا الركلات على مؤخراتنا من رجال القوات المساعدة.
ولم يخبرنا أحد أي طريق سلك، وهل كان في الدار البيضاء أصلا، وهل حلق فوقنا في السماء، وهل رآنا، ونحن ننتظر مروره، ثم ونحن نتصبب عرقا، وهل أشفق علينا، وهل عاقب مدير المدرسة الذي عرضنا للشمس، وهل عاتب أولياء أمورنا الذين لم يسألوا عنا. لم أكن معنيا بهذه التفاصيل، فقد كانت سعادتي غامرة، وعلاقتي به كانت طيبة جدا، سواء مر أم لم يمر أمام منزلنا وكنت أتمنى في قرارة نفسي، أن لا يتوقف عن التدشينات، التي كانت تعني يوم عطلة إضافيا، ومغامرات لا تنتهي،
وكم من مرة خدعْنا الملك الراحل، ولم نستقبله، إذ كنا ننسل من الطابور الطويل، مستغلين الفرصة، فنذهب رأسا إلى ساحة خلاء، نصطاد عصفور الدوري، ونريشه، ونشويه، ونملحه، ونأكله بعظامه. وعلى عكس الصورة التي كوناه عنه بعد أن كبرنا، فإنه لم يعاقبنا يوما، ولم يقس علينا، مع أن الحسن الثاني كان على علم بكل ما يقع في المملكة، وكان له مخبرون في كل مكان، ربما لأنه كان يعتبر هروبنا من الخدمة مجرد شقاوة أطفال، وليس مقصودا ولا عصيانا، وربما لأنه هو أيضا لم يمر من الطريق ذلك اليوم بسيارته، وربما ذهب هو الآخر في رحلة صيد، مثلنا تماما،
على أي حال، فقد كانت فرص مشاهدته كثيرة، وفي حالة ما إذا تعذرت رؤيته مباشرة في الطريق، فقد كان رحمه لله يقطع المسلسل المصري من الوسط، ويقطع نشرة الأخبار، ويقطع مباراة في كرة القدم، فيمر موكبه الملكي في شاشة التلفزيون، ونتبعه بعيوننا لساعات، مستمتعين بتعليق مصطفى العلوي، قبل أن نعود إلى استئناف ما فاتنا من البرامج.
وحين أتذكره اليوم، بمناسبة ذكرى مرور 18 سنة على رحيله، فإني أستعيد احتفالات عيد العرش، والشيخات، وافتتاح الإرسال، وسندباد، والليث الأبيض، ولاراف، ومطاردتها لنا، إلى غير ذلك من وسائل الترفيه المرتبطة بمرحلته، وإن نسيت فلن أنسى فضله علي في التغيب عن المدرسة، ولن أنسى ذلك المغرب الذي كان العيش فيه يشبه مغامرة خطرة، ولن أنسى المرات الكثيرة التي أسعد فيها كل كسالى المملكة الصغار. وأنا طفل، كانت علاقتي طيبة فعلا بالحسن الثاني، ومبنية على الاحترام، على عكس الكبار، الذين كانوا يشتكون من نظامه كثيرا، ومن وزيره في الداخلية، وعلاقتهم به كانت متوترة جدا، رغم أنه كان يبتسم لنا دائما، ويلوح لنا بيديه، ويمنحنا العطل، ويطل علينا من التلفزيون، ومن الصور المعلقة في حجرة الدرس، وفي المستوصف، وعند الحلاق، وفي كل مكان، وكان يقطع الفيلم، ويقطع المسرحية، ويقطع ماتش الكرة، ليتواصل مع رعيته، بينما المغنون يغنون له، وكان هو خبرنا الوحيد، وكان بطلا لمسلسلنا الطويل، الذي مازالت أحداثه مستمرة إلى اليوم، ومازال المغاربة يتابعونه، بنفس التشويق الذي كانوا يتابعونه به قبل عقود من الآن، مثل تيلينوفيلا مغربية لا تنتهي.
حميد زيد